
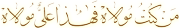
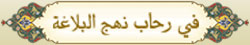


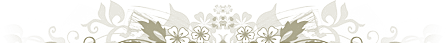

المدرس : حسام عدنان رحيم
جامعة القادسية - كلية الآداب
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (سورة النحل :١٠١)
الرموز المستعملة
استعمل الباحث بعض الرموز والاختصارات التي تدل على ما يأتي :
خ / رمز للخطب الواردة في نهج البلاغة .
ك / رمز للكتب .
قصا / رمز لقصار الكلمات .
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاءً ، وابتدأه ابتداءً بلا رويَّةٍ أجالها ، ولا تجربةٍ استفادتها.والصلاة والسلام على اشرف خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين .
فما زالت فصاحة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تأخذ بمجامع قلوب الفصحاء والبلغاء الذين بهرهم نهج أمير المؤمنين وسطعت على عقولهم كلماته الفصيحة التي حيَّرت اللغويين والأدباء في طريقة توظيفها ونظمها وتشكيلها ، حتى أصبحت أقواله ( عليه السلام ) بالمنزلة الثانية بعد القرآن الكريم ، وأحاديث النبي الأكرم اللذين استقى منها الإمام أساليبه وطرائقه في صناعة الكلام ونظمه .
ولسنا هنا في موضع الاحتجاج بأقوال العلماء من أهل اللغة والأدب في شأن بلاغة الإمام وتمكنه من الأداء اللغوي ، فهذا أبين من الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج لغة الإمام إلى برهان يمنحها شرف الإمكان والإفصاح .
وعلى حياءٍ من أمير البيان . حاولت أنْ أدرس نهج البلاغة في جزئيةٍ من جزئيات هذا الِِسِّفر الخالد ، فاخترت جانب المفردات لتكون مجالاً للبحث الذي جعلته دراسةً دلاليةً في ( ألفاظ الطِّيْب والعِطر ومتعلقاتها في نهج البلاغة ) بوصفها أنموذجاً لألفاظ الزينة ومتعلقاتها في نهج البلاغة ، وهذه كلها تشكل جانباً من جوانب المجالات والحقول الدلالية الواسعة في نهج البلاغة التي يشتغل فيها الباحث حالياً .
لقد قمت في هذا البحث باستقصاء ألفاظ الطِّيْب و العطر في نهج البلاغة، وتوزيعها بحسب نظرية الحقول الدلالية التي اتخذتها سبيلاً لدراسة هذه الطائفة من الألفاظ ؛ لأنَّ هذا المنهج يمكن الدارس من إظهار العلاقات الدلالية بين المفردات من ترادفٍ وتضادِ ومشتركٍ لفظي وغيرها ، فضلاً عن بيان قيمتها الموقعية من النص .
أمّا المنهج الداخلي الذي اتبعته في تناول المفردات فقد اتخذت من بيان معاني الألفاظ في المعجم العربي مُدخَلاً للولوج إلى دلالتها في نهج البلاغة ؛ لأجل المقاربة والموازنة بين الاستعمال المعجمي والاستعمال العَلَوي للمفردات ، ومن ثمّ الشروع بتحليل النصوص التي ترد فيها الكلمة في نهج البلاغة مُستعيناً بالمصادر التي تنقسم عندي في هذا البحث على قسمين ، الأول فهي كتب اللغة والمعاجم ، والثاني كتب الشروح التي عُنِيَتْ بشرح نهج البلاغة ، وغير ذلك من المصادر والمراجع التي أعانتني في إنجاز البحث .
وختاماً أدعو الله تبارك وتعالى أنْ يكون هذا البحث المتواضع مقبولاً عند إمام الفصاحة والبلاغة أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وأنْ ينال الرضا والاستحسان لدى الأساتيذ الأفاضل الذين سخَّروا أنفسهم لخدمة اللغة العربية لغة القرآن الكريم .
والحمد لله ربِّ العالمين
ألفاظ العطر والرياحين
وهي بحسب شيوعها في نهج البلاغة تنقسم على الآتي
١- طِيْب ( ٤ ) ح /١٩٢ ، ك ٤٥ ، قصا / ٣٩٧ ، ٤٠٠ . طيبا ( ١ ) قصا / ١٠٤ .
٢- ريحانة ( ٢ ) ك / ٣١ ، قصا / ١٢٠ . ريحانة ( ١ ) خ ١٦٠ .
٣- عَرْفُةُ ( ٢ ) خ ١٩٢ .
٤- المسك ( ٢ ) خ / ١٦٥ ، قصا / ٣٩٧ .
٥- ريحة ( ١ ) قصا / ٣٩٧ .
٦- عِطْر ( ١ ) قصا / ٣٩٧ . طِيْب ( ٤ ) طِيباً ( ١ )
الطَيِّب بالتشديد خلاف الخبيث [١]، قال علقمة الفحل : [٢]
يَحْمِلْنَ أُتْرُجة نَضْخُ العَبِيْرِ بِهَا **** كأَنَّ تِطْيَابَها في الأنْفِ مَشْمُوم
والطّيْبُ ما يُتَطَيَّبُ به [٣] . والطِّيْب على بناء فِعْل [٤]. وطعامٌ طيِّبٌ إذا كان سائغاً في الحَلْق [٥].
وقد استعمل الإمام ( عليه السلام ) مفردة ( طِيْب ) خمس مرات ٥، وكانت هذه اللفظة دالة عنده على الرائحة الطيبة الزكية ، إلا في موضع واحد استعملها الإمام فيه بدلالة الطيب من الطعام .
فأمّا المعنى الأول فمنه قوله متحدثاً عن خَلْقِ آدم ( عليه السلام ) ، وسبب خلق الله له من طينٍ دون أن يكون من نور : ((وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ وَطِيْبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ. . . ))[٦].
والطِيْبُ - ههنا - هو العِطر الذي يُبّهِر ويَعْظُم وَقْعُهُ في النّفس ، بسببٍ من قوة عَبْقهِ ونفوذهِ [٧].
ويدعم ذلك إيراده ( عليه السلام) مفردة (عَرْفُه) في السياق المتقدم نفسه ، والعَرْفُ هو الرائحة الطَّيِّبة والمُنْتِنَة معاً [٨]،ولمّا استعمل الإمام كلمة ( طِيْب ) في النص ، دَلّ على إرادة الرائحة الطيّبة .
ومن هذا المعنى أيضاً قوله ( عليه السلام ) في حديثه عن ( المِسْك ) وهو ضَرْبٌ من الطّيْب : ((نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِيحُهُ ))[٩] .
والمعنى نفسه أستعمله الإمام في ( قصا/ ٤٠٠ ) .
إمّا الدلالة الثانية - وهي الأقل شيوعاً في النهج - فهو استعمال لفظة ( طِيْب ) دالة على الطيب من وجوه الطعام الحلال .
وذلك في كتابه الذي يخاطب فيه عامله على البصرة ( عثمان بن حُنيف الأنصاري ) .
يقول فيه الإمام - بعد عتابه عثمان - : (( فََانْظُر إلى مَا تَقْضِمَهُ مِنْ هَذا المَقْضَمِ ، فَما اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ ، فَالفِظْةُ ، وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيْبِ وُجُوْهِهِ ، فَنَلْ مِنْهُ)) .
والسياق - ههنا - سياق تحذير وتعليم يؤكد فيه الإمام ( عليه السلام ) على ضرورة التثبت من حلال المُطَعَم ، وتجنب حرامه بورعٍ واجتهادٍ .
ولهذا عَطَف ( عليه السلام ) على كلمته المتقدمة قوله : ((أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ )) [١٠].
وتأكيداً لهذا المعنى ينصح الإمام عامله على التّيَقُنِّ من ( طِيْبِ ) وُجُوْهِ مَأكله . أي التّثَبّت من مصادِر هذا المأكل .
والتأكد من حِلَّهِ و طِيْبِ وَجّهِ اكتسابِهِ [١١].
فصارت لفظة (طِيْبِ ) هنا ترادف لفظة ( الحلال ) أو تساويها في الدلالة .
رَيْحَانَة ( ٢ ) ك / ٣١ ، قصا / ١٢٠ . رَيْحَانُهُ ( ١ ) خ
الرَّوْحُ بَرْدُ نَسيِم الريح [١٢].
والرَّيْحَةُ نَبَات أخْضَر بَعد مايَيْبَسُ وَرَقَهُ وأعالي أغصَانه .
والعَرَبُ تُسَمِّيها الرَّيْحَةُ [١٣].
ويقال الدُّهْنُ المُرَوَّح أي المُطَيَّبُ [١٤].
والرَّيْحَان نبتٌ معروف [١٥].
وهو - أي الرَّيْحَان - بقْلٌ طَيِّب الرِّيح ، واحدته ريحانة ، والجمع رَياحِين .
وقيل : إن الرَّيْحَان أطراف كل بَقْلةٍ طيّبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور[١٦] وفي الحديث : (( إذا أُعْطِي أَحَدُكم الرَّيْحَان فَلا يَرُدَّه )) [١٧].
وهو مثلما علّق عليه ابن الأثير - كل نبتٍ طيبٍ من المَشْمُوم [١٨].
وقيل إنّ الريحان اسم جامع للرياحين الطيّبة الريح [١٩].
والعرب تسمّي الرزق ريحاناً أيضاً على التشبيه ، ومنه قولهم : خرجت ابتغي رَيْحَان اللهِ .
أي رزقه [٢٠].
وبه فُسّر قوله تعالى : (( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ )) [٢١]، فقد أشار المفسرون إلى أن قوله تعالى (وَرَيْحَان) يراد به الرزق الطيّب [٢٢].
أو مطلق الرزق كما ذهب إلى ذلك ابن منظور من اللغويين [٢٣].
وقد اجمع اللغويون إن ( ريحاناً ) من ذوات الواو ،والأصل فيه (رَيْوَحَان) بياء ساكنة ، ثم واو مَفتوحة [٢٤].
وقلبت الواو ياءً لمجاورتها الياء ، ثم أدْغمت وخُفِّفَتْ على حدّ لفظة (مَيْت) ، ولم يستعمل هذا اللفظ مشدداً بعد قلب واوه ياء ، وذلك لمكان الزيادة فيه ، فكأنها عوض من التشديد [٢٥].
وقد استعملت مفردة ريحان في نهج البلاغة ثلاث مرات [٢٦]، واحدة منها وصف بها الإمام (عليه السلام) المرأة بـ (انها رَيْحَانَة ) وذلك في وصيته للإمام الحسن (عليه السلام) التي كتبها له عند مُنْصَرَفِه من صِفّين . وفيها يتحدث عن المرأة وكيفية معاملتها .
يقول (سلام الله عليه) : ((. . . وَلَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ [٢٧])) [٢٨].
ووصفه (عليه السلام) للمرأة بـ (الرَّيْحَانَة) سبيل إلى بيان أنها غَضّة طَرِيّة طيبة النَّفْس والروح ، وهذهِ هي الفطرة الإلهية التي فطرها الله عليها - وقد علّق ابن ميثم على هذا الضرب من الاستعارة بقلة : ((واستعار لفظة الريحانة باعتبار كونها محلا للذة والاستمتاع بها ، ولعل تخصص الريحانة بالاستعارة لأنّ شأن نساء العرب استعمال الطّيب كثيرا)) [٢٩].
وهذا وجه مقبول لديَّ علاوة على ما قدّمته ، ولعل استعمال الإمام (عليه السلام) لمفردة (قهرمانة) ضداً لمفردة ريحانة يمثل دلالة (الريحان) خير تمثيل في هذا السياق ، إذ الريحان كما تقدم - يَقْلٌ طَرِيُّ غَضٌ طَيِّب الرائحة ، فهو على العكس - بدلالة هذهِ - من المتسلط القاهر الذي يتحكم بالأمور دونما روية أو عدل متجاوزا سلطات نفسه ، وهو ما يصوره الإمام (عليه السلام) بمفردة (قهرمانة) ، وهذه اللفظة فارسية معربة ، تطلق على مَنْ يملك التَصّرف في الأمور [٣٠].
وفي هذا التعبير العلوي قضية اجتماعية ، فقد استعار الإمام لفظة (قهرمانة) على سبيل الكناية لُيْظهِرَ أنّ المرأة لم تُخْلَق لتكون حاكمة متسلطة بل من شأنها أن تكون زوجة محكومة بطاعة زوجها ، وذلك فيما يرضي الله تعالى . فإنّ المرأة إنما خُلِقَت للرقة والحنان والدعة والمطمئنان بحسب ما يقول الشيخ محمد جواد مغنية [٣١].
وهذا الأمر يدعونا إلى إن نفهم الفارق بين كونها (ريحانة) أي طيبة محبوبة كما هو الريحان، طيب الرائحة، فهي بذلك محبوبة مصانة ينبغي إن تعامل برقة، فتكون لها حضورها العاطفي في قلب الزوج [٣٢].
أمّا الموضع الثاني الذي جاءت فيه مفردة (رَيْحَانَة) فهو قوله (سلام الله عليه) وقد َسُئِلَ عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ ،وبني مَخْزُومٍ : ((أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ وَالنِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ . . . )) [٣٣].
وسياق حديثه (عليه السلام) سياق مَدْحٍ ، وقد عبّر الإمام عن هذا الضرب من المدح لبني مخزوم بـ (ريحانة قريش ) .
أي أنهّم لُبُّ قريش ، وصفوتها وبنو مخزوم بَطن من قريش ، وهو مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك [٣٤].
وقيل كان مخزوم هذا ريح طَيّبة كالخزامي ، ولون كَلَوْتِهِ .
ويبدوا أنّ هذا المعنى هو الذي دعاهم إلى أنّ يسمّوا هذا البطن من لؤي بن غالب بن قريش (ريحانة قريش) لريحه الطيبة [٣٥].
ويبدو أنّ هذهِ الدلالة أو التسمية الغالبة على بني مخزوم كانت شائعة كما يفهم من كلام الشيخ ابن ميثم البحراني ، ولهذا ضَمّنها الإمام (عليه السلام) في كلامه ، فضلاً عمّا تدل عليه مفردة (ريحانة ) من معنّى يشتمل على طِيْب الرائحة والمنزلة بين الأشجار ، فيكون المعنى الذي قصد إليه الإمام أنهم - بنو مخزوم - في قريش بمنزلة الريحان في الأشجار [٣٦].
وذهب بعض الشّراح إلى أنّ قوله (عليه السلام) (بنو مخزوم ريحانة قريش) ليس وصفاً من إنشائه (عليه السلام) وإنما كان مقولاً قبله ، وقد فسّر الإمام بتفسير حَسنٍ بَأَنْ لم يُقْصر الأمر على حب النكاح في نسائهم ، بل زاد عليه حب حديث رجالهم .
واستدل على ذلك بالحوار الذي دار بين خالد ابن عبد الرحمن المخزومي ، وأبي الصَّقّعَب التميمي من تَيْمِ الرّبَاب ، فسأله خالد عن قبيلته ، فأجابه بأنه من تَيْمِ الرّبَاب.
فقال له خالد : ما أنت من سَعْد الأكثرين ، ولا حنظلة الأكرمين ، ولا عمر الأشدّين .
فقال أبو الصقعب .فَمِمّن أنت ؟ قال : من بني مخزوم .
قال نحن ريحانة قريش فقال أبو الصقعب : قبحاً لما جئت به ، وهل تدري لم سُمِّيت مخزوم ريحانة قريش ؟ سُمِّيت بِحَظْوَةِ نسائها عند الرجال . فأقْحَمَهُ [٣٧]. علاوة على هذه الرواية ، فإنّ قوله (عليه السلام) (ريحانة قريش) يتناسب مع دلالة (الريحان) على المرأة أو وَصْف المرأة بـ (الريحانة) لفضاضتها ورقتها وطيب نفسها . وهذا الأمر محتمل وقريب مما قصده الإمام فيما احسب .
وجاء الوضع الثالث الذي استعمل فيه الإمام (عليه السلام) لفظة (رَيْحَانُةُ) بصيغة الجمع في سياق حديثه عن عيسى عليه السلام أو بدلالة الريحان المأكول أي الطَّيِّب المَطْعَم : ((وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ( عليه السلام ) فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَيَلْبَسُ الْخَشِنَ وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ . . . وَفَاكِهَتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ)) [٣٨].
وفي كلام الإمام (عليه السلام) استعارة ، فقد استعار لفظ الفاكهة والريحان لم تنبته الأرض [٣٩].
من طَيّب المأكول طعماً ورائحة .
رِيْحُهُ ( ١ ) قصا / ٣٩٧
ومن الاشتقاق نفسه لمفردة (رَيْحان) استعملت مفردة (رِيْحُهُ) عند الإمام (عليه السلام) ، والرّيْحُ في اللغة نَسِيْمُ الهواءِ ، و نَسِيْمُ كلِّ شيءٍ ، وهي لفظة مؤنثة [٤٠].
والرِّيْحَةُ طائِفَةٌ من الرِّيح [٤١].
وقيل في عِلّة تسمية الريح بهذا الاسم ، لأن الغالب عليها في هبوبها المَجِيءُ بالرَّوْح والرّاحَة ، وإنّ انقطاع هبوبها يُكْسِبُ الكرْبَ والغَمَّ والأذى ، وهي بذلك تكون مأخوذة من الرَّوْح[٤٢] .
ومن الدلالة الأخرى لهذا الجذر اللغوي هو استعمالها - أي مفردة ريح - للإشارة إلى الرائحة الطيّبة، فالرّيح الشّيء الطيِّب والرائحة رِيْحٌ طيّبةٌ نجدها في النَّسِيم [٤٣].
وقد استعمل الإمام هذه اللفظة عند حديثه عن (المِسْك) بقوله : ((نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِيحُهُ )) [٤٤].
ويقصد الإمام بمفردة(ريحة) الرائحة الطيّبة التي تصدر عن المسك ، وقد ذكر بمجاورة هذه اللفظة (عَطِرٌ) وهي مفردة تُعَزّز المعنى المقصود .
عَرْفُةُ ( ٢ ) خ ١٩٢(٢)
عَرَفَ الرَّجُل إذا أكثر من الطّيِّب[٤٥] ، والعَرْفُ الرِّيْحُ طَيِّبَة كانت أومُنْتَنِةً ، وأكثر استعماله في الرِّيح الطَّيِّبَةِ[٤٦] .
ومنه قول الشاعر [٤٧]:
ثَنَاءٌ كَعَرْفِ الطِّيْبِ يُهْدَى لِأَهْلِهِ ***** وَلَيْسَ لَهُ إلاّ بني خالدٍ أَهْلُ
ومنه - أيضا - الحديث : (( مَنْ فَعَلَ كذا وكذا لم يَجِد عَرْفَ الجَنَّةِ ))[٤٨].
أي رِيْحَها الطّيِّبَةِ [٤٩].
والتَّعْرِيْفُ التَّطْيِيْبُ من العَرْف [٥٠].
والعَرْفَةُ قَرْحَةٌ تخرج في بياض الكَفِّ .
يقال عَرَفَ الرجلُ ، فهو مَعْرُوف إذا خرجت به تلك القَرْحَة [٥١].
والعُرْفُ بالضم الجُود والكرم [٥٢].
والعُرْفُ شجر الاتْرُجُّ ، والعُرْفُ النَّخْلُ إذا بَلَغَ الإطعام [٥٣].
وقد ورد في نهج البلاغة استعمال لفظ (عَرْفُه) مرتين [٥٤]،كلتاهما بدلالة الرائحة الطيبة الزكية التي تأخذ الأنفاس ، وكان الاستعمال الأول منهما في سياق حديثه (عليه السلام) عن خَلْق آدم (عليه السلام) .
يقول : ((وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ ، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ ، وَطِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ ، لَفَعَلَ. . . )) [٥٥].
والعَرْف هو ما يُشَمُّ من رائحة طيّبة ، وقد أراد (عليه السلام)- ههنا- الرائحة الطيّبة التي يَعْظُم وَقْعُها في النفوس ، ويَعْظُم تأثيرها في الخياشِيم من عَبْقَةِ ريحها ونفوذه [٥٦].
وأمّا المعنى الآخر، فهو في سيِاق حديثه (سلام الله عليه) عن علاقته بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وقُرْبهِ منه بعد حديثه عن شجاعته وفَضْلِهِ. يقول الإمام : (( أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ . وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ ، وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ ، وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ ، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ)) [٥٧].
وقد اتخذ الإمام (عليه السلام) من هذه المفردات الواردة في النص سبيلا لبيان قوة ارتباطه بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولِيُبَيّن أنّه رَبِيْب رسول الله، فذكر قوله (وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ) للدلالة على شدة القُرّب مِنه.
وعَرْفُ النبي رِيْحُهُ الطيبة الزكية وقد أشار (عليه السلام) بقوله (وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ) إلى حصول التبرّك بملامسة جسم الرسول ، وذلك إشارة إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (( مَنْ مَسَّ جِسْمُهُ جِسْمِي لم تَمَسُّهُ النار[٥٨])) .[٥٩]
أو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((مَنْ مَسَّ دِمِي دَمَهُ لم تُصِبْهُ النار)) [٦٠].
وذلك كله يستلزم شَمَّ عِطر النبي الأكرم ورائحة جسمه الزكية .
وقد ذهب بعض الشراح إلى تفسير لفظة (عَرْفة) في نص الإمام المتقدم بـ (عَرَقة) وهي إشارة منه إلى انه (عليه السلام) كان يشم رائحة عَرَق جسم النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) [٦١].
وهو أمر بعيد عندي ؛ لأنّ عَرْف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طيّب ، ولا تصدر منه إلاّ رائحة طيبة مثلما هو معروف .
المِسْك ( ٢ ) خ / ١٦٥ ، قصا / ٣٩٧
المِسْكُ الطيب عن ابن الإعرابي[٦٢].
وهو المَشْمُوم عند اللغويين [٦٣].
وهو ضَرْبٌ من الطّيْب مذكر ، وقد أنثّه بعض اللغويين واحدته مِسْكَة [٦٤]. واصلة (مِسَك) محرّك السين [٦٥].
و(المِسْكُ) من الطَّيْب فارسي معّرب ، كانت العرب تُسَمِّيه المَشْمُوم [٦٦].
وقد نصّ على أعجميّة هذهِ اللفظة الجواليقي أيضاً [٦٧].
وثَمَّة ضَرْبٌ من المِسْك يُؤْخَذُ من نَبْتِ البَرَّ، وهو أطْيَبُ من الخُزَامي كما يقول اللغويون [٦٨].
و(المِسْك) مفردة استعملت في نهج البلاغة مرتين[٦٩] ؛ بدلالة المِسْك ذي الرائحة الطيبة الجليلة .
يقول (عليه السلام) في صفة الجنة ، وما فيها من روعة وبهجة : ((فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَمَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا)) [٧٠].
والنص يصوّر - بأسلوب مجازي - صورة من صور الجنة ، وقد اتخذ الإمام (عليه السلام) أسلوب الاستعارة لإظهار هذا الوجه من جمال الجنّة ، فجعل (كثبان المسك) أرضا تنبت فيها عروق أشجار الجنّة .
وهذه التِلال مكونة من المِسك طيّب الرائحة بدلاً من التراب الحقيقي ، فكيف ستنمو هذهِ الأشجار إذا كانت كثبانها من المِسْك .
وثَمّة موضع آخر امتدح فيه الإمام (عليه السلام) (المِسْك)، وهو الطّيْب المعروف ، ووصفه بخفة المحمل ، وعِطْر الرائحة وجمالها .
وذلك في (قصا / ٣٩٧) . عَطِر ( ١ ) قصا / ٣٩٧ .
العِطْر أسم جامع للأشياء التي تعالج للطِّيْب ، ويُسَمّى بَيّاعُهُ ( العَطّار) وحرفته ( العِطارة ) .
يقال : رجل عَطِر ، وامرأة عَطِرة ، إذا كانا طَيِّبَي الرِّيح ، وإنْ لم يَتَعَطّرا [٧١]. والعِطْر الطِّيْب وجمعه عُطُور [٧٢].
ويقال : رجل مِعْطَار وامرأة مِعْطَار، أي كثيرا الاستعمال للعِطْر [٧٣] .
وفي الأمثال السّائرة (( دَقّوا بَيْنَهُم عِطْرَ مَنْشَم )) [٧٤] .
قيل إن منشم امرأة من خزاعة كانت تبيع العِطْر في الجاهلية فَتَطَيَّبَ قَوْمٌ بِعِطْرِها وتحالفوا على الموت فجرى المثل بذلك [٧٥] .
وقيل بل هو من قولهم ( مَنْ شَمَّ هذا العِطْر ) ، وهو رأي ضعيف ، وذهب الأصمعي إلى أن (مَنْشَم) يعني ( فَشَا ، وانتشر ) وهو لا يكون إلاّ في الشَّرِّ [٧٦].
وردت مفردة ( عَطِر ) في كلام الإمام علي ( عليه السلام ) مرة واحدة [٧٧]. وذلك بدلالة الطِّيْب عند حديثه عن ( المِسْك ) وصفاته .
يقول الإمام : ((نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِيحُهُ )) [٧٨].
يريد ( عليه السلام ) أنّ المِسك عَطِر الرائحة طَيِّبُها وهو من محمود العطور وأجلّها .
ومن الجدير بالذكر أنّ مفردة ( طِيْب ) قد وردت في كلمات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (( حُبِّبَ إليَّ مِن دُنْيَاكم ثلاث ؛ الطِّيْب ، والنّساء ، وَقُرَّة عَيْني الصّلاة )) [٧٩].
نتائج البحث
وقد توصل البحث إلى جمهرة من النتائج التي تظهر القيم الدلالية للألفاظ موضوع البحث لعل من أهمها .
فضلاً عن أنَّ الإمام ( عليه السلام ) استعملها دالة على المكانة الاجتماعية والسياسية لقبيلة بني مخزوم الذين عدّهم ( ريحانة قريش ) أي قلبها ولبّها .
قائمة المصادر والمراجع