
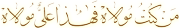
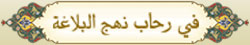


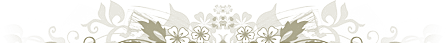

كاظم حمد المحراث
وتكاد مضامين الحثّ على التقوى أن تطغى على أيّةِ دعوة زهدية أُخرى ، كمّاً ونوعاً ، وتعدّت الصِيَغ والأساليب المعهودة ، وأدخلت ـ في نهج البلاغة ـ تفاصيل يصعب حصرها بإيجاز ; حتّى لا يكاد مضمون زهدي ، أو دعوة إليه ، يجري دون أن يُفتتحَ بالدعوة إلى اتّقاء الله :( اتّقوا الله ) لفظاً أو معنىً.
الفدية : الفداء. أرهقتهم : غشيتهم.
القوادح : جمع قادح ، وهو أُكام يقع في الشجر والأسنان.
أوهقتهم : جعلتهم في الوَهَق ; وهو حبل كالطوَل. والقوارع : المِحَن والدواهي.
ضعضعتهم : ذلّلتهم.
عفّرتهم : كبّتهم على مناخرهم في العفر ; وهو : التراب.
المناسـم : جمع مِنْسَم ، وهو مقدّم خفّ البعير ، أو الخفّ نفسه.
دان لها : خضع.
أخلد إليها : ركن لها.
السَغَب : الجوع.
الضنك : الضيق.
لا يدعون ركباناً : لا يقال لهم ركبان : جمع راكب ; لأنّ الراكب من يكون مختاراً ، وله التصرّف في مركوبه.
الأجداث : القبور.
الصفيح : وجه كلّ شيء عريض ; والمراد : وجه الأرض.
الأجنان : القبور.
الرُفات : العظام المندقّة المحطومة.
وتبدو الملازمة جليّة بين الدعوة إلى الزهادة والحثّ على التقوى ، وكثيراً ما يحلّ مصطلح الزهد بدل مصطلح التقوى ، فهما ـ في نهج البلاغة ـ مصطلحان يتناوبان كثيراً ، ويعطي أحدهما معنى الآخر في كثير من الدعوات والنصوص ; فتارةً يأخذ التقوى معنىً لازدراء محاسن الدنيا ، وتحقير ملذّاتها ، والالتفات إلى الآخرة ، وتعظيم نعمها... وهذا هو الزهد..
« اتّقوا الله ! فما خُلِق امرؤ عَبثاً فيلهو ، ولا تُرِك سُدىً فيلغو ، وما دنياه التي تَحَسَّنَتْ له بخَلَف من الآخرة التي قبّحها سوء النظر عنده ، وما المغرور الذي ظَفرَ من الدنيا بأعلى هِمَّته كالآخر الذي ظَفرَ من الآخرة بأدنى سُـهمته » [١]..
وتارة يتّخذه دعوة للاعتراف بنِعم الله على عباده في الدنيا..
« أُوصيكم عبادَ الله بتقوى الله ، الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقّت لكم الآجال ، وألبسكم الرِياش ، وأرفغ لكم المعاش ، وأحاط بكم الإحصاء ، وأرصد لكم الجزاء ، وآثركم بالنِعمِ السوابغ... أنتم مُختبرون فيها ، ومُحاسبون عليها » [٢]..
وثالثة ، فالتقوى يعني الاستفادة ممّا يلي من مكنون النفس وحدودها ، وما يحيط بخلجاتها ، ومواجهة غرائزها ، والاعتراف بمعاصيها ، وإلزامها بالعودة إلى حدود الله... وهذا هو الزهد أيضاً..
« اتّقوا الله تقيَّةَ مَن سمِع فخَشعَ ، واقترف فاعترف ، ووجِل فعمِل ، وحاذَرَ فبادَر ، وأيقن فأحسَنَ ، وعُبِّر فاعتبر ، وحُذّر فحذر ، وزُجِر فازدجر ، وأجاب فأناب ، وراجع فتاب ، واقتدى فاحتذى ، وأُرِيَ فرأى ، فأسرع طالباً ، ونجا هارباً... » [٣].
ويدخل الزهد في تفاصيل التقوى وطريقته ، وفي عرض صفات الإنسان التقي ومسـيرته ، وهو وصف يؤكّد للدارس أنّ صفات التقي في نهج البلاغة هي صفات الزاهد نفسها ، وبالتالي فإنّ التُقى يعادل الزهد..
« اتّقوا اللهَ عبادَ الله ! تقيَّةَ ذي لبّ شغل التفكّر قلبَه ، وأنْصَبَ الخوفُ بدنَه ، وأسهر التهجّد غِرارَ نومه ، وأظمأ الرَجاءُ هواجرَ يومه ، وظَلَفَ الزهدُ شهواته ، وأوجَفَ الذكر بلسانِهِ ، وقدَّم الخوفَ لأمانهِ...
ولم تفتِلْه فاتِلاتُ الغُرور ، ولم تَعْمَ عليه مُشْتبهاتُ الأُمور ، ظافراً بفرحة البشرى ، وراحةِ النعمى ، في أنْعَمِ نومه ، وآمنِ يومه. قد عبر مَعْبَر العاجلة حميداً ، وقَدَّم زادَ الآجلةِ سعيداً ، وبادر من وَجَل ، وأكْمَشَ في مَهَل ، ورغِبَ في طَلَب ، وذهب عن هَرَب ، وراقبَ في يومه غَدَه ، ونظر قُدُماً أمامه ; فكفى بالجنّةِ ثواباً ونوالاً ، وكفى بالنارِ عقاباً ووبالا !... » [٤].
والعبادة التي يجهر بها نهج البلاغة ، ويريدها منهجاً للمؤمنين ، تشتمل على الحثّ الدائم على إمكانية نيل أفضل درجات التقرّب إلى الله ، وبالتالي فهي لا تخرج من دائرة الزهد نفسِها التي يطلّق فيها الزاهد حبَّ المالِ ، وحبّ الأولاد ، ووجاهة الدنيا ، ونعيمها... ويرضى بما عند الله ، ويقنع به ، وأن يخافه ـ جلّ شأنه ـ خوفَ مَن يراه ، ويرهب سطوته ، رهبةَ عالم بها ، ويعمل لنيل ثوابه في اليوم الآخر.
فالعبادة هنا ، عبادة زاهدة ، فيها من الإخلاص والتوجّه المطلق ، والانشغال بها ، ما يبعدها عن أن تكون أداءً لطقوس يومية ، أو فرائض شهرية واجبة حسب..
« فوالله ! لو حَنَنْتُم حنينَ الولَّهِ العِجَال ، ودَعَوْتُم بِهَديلِ الحَمام ، وجَأرْتُم جُؤارَ متبتّلي الرُهْبان ، وخرجتُمْ إلى الله من الأموال والأولاد ; التماسَ القُرْبَةِ إليه في ارتفاعِ درجة عنده ، أو غفرانِ سيّئة أحصتها كُتُبُه ، وحَفِظَتها رسلُه ، لكان قليلاً في ما أرجو لكم من ثوابه ، وأخافُ عليكم من عقابه » [٥].
وتبيّن الجملتان الأخيرتان من هذا النصّ شـدّة اهتمام عليّ (عليه السلام)بالعباد ، وحرصه على توجيه كيفيّة عبادتهم ونوعيّتها ، وتبيّنان طبيعة المهمّة التي يحملها ، وهي مهمّة توجيه أخرجته من الأنانيّة الفرديّة في العبادة إلى مسؤوليّة جسيمة في حمل الجماعة على الدين الأُصولي ، بصورته النقيّة التي بشّـر بها الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والتي سار عليها الرعيل الأوّل من صحابته ( رضوان الله عليهم ) ، والتي يبيّن النصّ الآتي بعض كيفيّاتها :
« لقد رأيتُ أصحابَ محمّد صلّى الله عليه فما أرى أحداً يُشبهُهم منكم ; لقد كانوا يُصبِحون شُعْثاً غُبْراً ، وقد باتوا سُجّداً وقياماً ، يُراوحون بين جباهِهم ، وخُدودِهم ، ويقفون على مثلِ الجمر من ذِكْرِ معادِهم ، كأنّ بين أعْيُنهِم رُكَبَ المِعْزَى من طولِ سُجُودِهم ، إذا ذُكِرَ اللهُ هَمَلَتْ أعيُنُهم حتّى تَبُلَّ جيوبَهم ، ومادوا كما يميدُ الشجرُ يومَ الرِيحِ العاصف ، خوفاً من العقاب ، ورجاءً للثوابِ » [٦] .
وأيضاً ، لم يزلْ يرسّخها في الأذهان ، ويقوّيها في القلوب ، وتراه لا ينصرف عنها حتّى وهو في رمق حياته الأخير ، بل إنّه ـ في موقف الموت ـ يجعل من نفسه عبرةً للآخرين ، وعِظةً لهم ، لعلّهم يلتفتون إلى أنّ ما حلّ به سيكون النتيجة الحتميّة لكلّ حيّ قبله وبعده..
وبدا كأنّه يريد التأكيد على صدق دعواته الزهديّة التي مرّت بلا اهتمام عند أغلب الناس..
« كنتُ جاراً جاوركم بدني أيّاماً ، وستُعْقَبونَ منّي جثّةً خلاءً ، ساكنةً بعد حَراك ، وصامتةً بعد نُطْق. ليَعِظَكم هُدوئي ، وخفوتُ إطرافي ، وسكون أطرافي ; فإنّه أوعظُ للمعتبِرين من المنطق البليغ ، والقول المسموع.
وداعي لكم وداع امرئ مُرْصَد للتلاقي ! غداً تَرَوْنَ أيّامي ، ويُكشَفُ لكم عن سرائري ، وتعرفونني بعد خلوِّ مكاني ، وقيامِ غيري مَقامي » [٧] .
وأنا مؤمن تمام الإيمان بأنّ هذه المهمّة قد وضعت لعليّ (عليه السلام) وضعاً ربّانيّاً ، جعلته يحمل يقيناً مطلقاً بثراء ما وهبه الله للإنسان من نِعَم في الحياة ، وبأفضليّة ما ينتظره من ثواب بعد الموت ، وكأنّه يرى تلك الحقائق رؤية العين ، ويلمسها لمس اليد..
« وتا للهِ ! لو انماثَتْ قلوبُكم انمياثاً ، وسالت عيونكم ـ من رغبة إليهِ أو رهبة منه ـ دماً ، ثمّ عُمِّرْتُم في الدنيا ـ ما الدنيا باقيةٌ ـ ما جزت أعمالكم ـ ولو لم تُبْقوا شيئاً من جُهْدِكم ـ أنْعُمَهُ عليكم العِظامَ ، وهُداه إيّاكم للإيمان » [٨]..
يقابلها عجز المعرفة البشرية ، ومحدوديّة معلوماتها عن جوهر تلك النِعم وعمقها ، ويظهر أنّ الإشفاق على محدوديّة علم البشر متأتّ من معرفة الإمام عليّ (عليه السلام) العميقة بأسرار الكون والخلق والوجود ، بمعنى : إنّه يعرف من بواطن الأُمور ، وخفايا الأشياء ، ما لا يعرفُ سائر البشر.
ومن يبغي التعرّف على بعض من علمه (عليه السلام) في نشأة الأرض والسماء ، وتكاثر البشر ، ودورات الحياة ، وعن نهاية العالم ، وعن تراكم الثروات التعدينيّة ، وعن ربط حياة مخلوقات الأرض والبحر والجو ، والليل والنهار ، فليرجع إلى كتاب د. مهندس عبد الهادي ناصر ، الموسوم بـ : نظرات في الكون والقرآن ، والمتّكئ في استنتاجاته العلمية على القرآن الكريم وكتاب نهج البلاغة..
ومن هذا العلم الذي استُودِع عنده ، استمدّ عليّ (عليه السلام) ركائز الإيمان الذي قاد إلى التقوى ، والورع ، والعبادة ، والزهد بأشكاله الصحيحة البعيدة عن التطرّف والانحراف والغلوّ.
وصارت أخبار الأوّلين ، وأحداث التاريخ القريب منها والبعيد ، باعثاً لاستنتاج العِبَر ، وطرح المواعظ ، ووُظِّفَت ـ في نهج البلاغة ـ بأساليب خطابيّة ذات مضامين زهديّة ، لامست الحسّ الديني لدى الأفراد ، وكان أمير المؤمنين يُدرك أنّ العباد بحاجة إلى التذكير الدائم ، وأنّ مهمّته الدينيّة تستدعي الإلحاح المستمرّ ، وإلقاء الحجج على البشر في بيان فضل الله ، وفي أُصول الإسلام ، وفي قيمة حياة ما بعد الموت ، والمقارنة ، والترغيب ، والترهيب..
« أوَ ليس لكم في آثار الأوّلين مزْدَجرٌ ، وفي آبائِكم الأوّلين تبصِرةٌ ومُعَتَبر ; إن كنتم تعقِلون ؟!
أوَ لم تَروا إلى الماضين منكم لا يرجعون ، وإلى الخَلَفِ الباقين لا يبقون ؟!
أَوَلَسْتُم تَرَون أهلَ الدنيا يُمسون ويُصبحون على أحوال شتّى : فميّتٌ يُبْكى ، وآخَرُ يُعَزَّى ، وصريعٌ مُبتلى ، وعائد يعود ، وآخرُ بنفسه يجود ، وطالبٌ للدنيا والموتُ يطلبُه ، وغافلٌ وليس بمغفول عنه ; وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي ! » [٩].
وليس هذا فحسب ، بل إنّه كثيراً ما يسترفد العِبرةَ ، ويبثّ الحكمة ، ويستخلص النصيحة ، بالاعتماد على تجربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أعمامه وعشيرته الأقربين ، وعلى الصراع غير المتكافئ بين الإسلام والشرك ، والقوّة القليلة التي غلبت فئةً كثيرة بإذن الله ، كي يتّخذ من هذا كلّه ، وذاك كلّه ، برهاناً على صدق التجربة الزهدّية المأخوذة من صميم الإسلام ، والتي ينادي بها ويسعى لتحقيقها..
« لقد كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ، ما يزيدُنا ذلك إلاّ إيماناً وتسليماً ، ومُضيّاً على اللَقَمِ ، وصبراً على مَضَضِ الألم ، وجـدّاً في جهاد العدوِّ..
ولقد كان الرَجل منّا والآخرُ من عدوِّنا يتصاوَلانِ تصاوُلَ الفَحْلين ، يتخالسانِ أنفسهَما ، أيُّهما يسقي صاحبَه كأسَ المنون ، فمرّةً لنا من عدوِّنا ، ومرّة لعدوّنا منّا ، فلمّا رأى الله صِدْقَنا أنزل بعدوّنا الكَبْتَ ، وأنزلَ علينا النصر ، حتّى استقرّ الإسلام مُلقِياً جِرانَه ، ومتبوِّئاً أوطانه » [١٠] .
مضامين وحدانيّة الله عزّ وجلّ في نهج البلاغة :
في الفلسفة الوجوديّة ، يفصل موضوع الإيمان بوجود الله وإنكار وجوده ، بين التديّن والإلحاد ، وخرجت من عباءة هذين الموضوعين نظريّات واتّجاهات فلسفية شتّى ، لكنّها كلّها ـ كما نرى ـ لا ترقى إلى مضمون النظريّة القرآنيّة المبرهنة على وجوده المتعالي ، وهي نظريّة استفادت الفلسفة الإسلاميّة منها في المعرفة والتنظير..
ولأنّ موضوع هذا البحث لا يتّخذ القرآن مادةً له ، فإنّنا نترك للقارئ حريّة التوجّه إلى الدراسات والتفاسير القرآنيّة ، والتعرّض إلى المباحث التي تهتمّ بهذه الإشكاليّة.
لكن الذي يهُمّنا هنا ، إنّنا نجد في نهج البلاغة نصوصاً تتساوق مضامِينُها مع مضامين الفلسفة القرآنيّة المشار إليها ، تحيط الناس ببراهين وحدانيّته سبحانه وتعالى ، وكُنه وجـوده..
يأتي بعضُها مخصّصاً لهذا الغرض ، في مثل : «... سَبَقَ الأوقاتِ كَوْنُه ، والعَدَمَ وجودُه ، والابتداءَ أوَّلُه. بتشعيره المشاعر عُرِفَ أنْ لا مشعَرَ له ، وبمضادّتِه بين الأُمور عُرِفَ أنْ لا ضدّ له ، وبمقارنته بين الأشياء عُرف أنْ لا قرينَ له. ضادّ النورَ بالظُلمةِ ، والوضوحَ بالبُهْمَةِ ، والجمودَ بالبللِ ، والحَرُورَ بالصَرْدِ...
لا يُشْمَلُ بحدّ ، ولا يُحْسَبُ بعدّ ، وإنّما تَحُدّ الأدواتُ أنفسَها ، وتشير الآلاتُ إلى نظائرِها. منعتها « منذُ » القِدْمة ، وحمتْها « قـد » الأزليّة ، وجنَّبتها « لولا » التكملة ، بها تجلّى صانعها للعقول ، وبها امتنع عن نظر العيون... » [١١] .
وهذا نصّ طويل ، يحتاج إيراده كاملاً ، وتحليله مفصّلاً ، إلى بحث مسهب قائم بذاته.
أمّا القسم الآخر من المضامين المخصّصة لبيان وحدانيته تعالى فإنّها تأتي في سياق التذكير والتزهيد ، والحقّ أنّ هذا السياق الخطابي الأخير يستدعي توطئة تستميل القلوب ، وتصرف إليه الأذهان ; إذ أنّ تشديد الخطاب على وجوده الأوحد ، ووصف خلقه جلّ وعلا ، أمرٌ يجعل المتلقّي أكثر ثباتاً على الإيمان ، وأشـدّ تمسّكاً بالتقوى ، وأقرب إلى اعتناق ما يجهر به الخطيب..
من ذلك : « الحمدُ للهِ المتجلّي لخَلقِهِ بَخَلْقِهِ ، والظاهر لقلوبهم بحجّته من غير رَوِيَّة ; إذ كانت الرويّاتُ لا تليقُ إلاّ بذوي الضمائرِ ، وليس بذي ضمير في نفسه. خَرَقَ عِلمُه باطنَ غَيْبِ السُتُراتِ ، وأحاطَ بغمُوضِ عقائدِ السريراتِ... » [١٢] .
للانفعال المخصوص الذي يعرض لها من المواد ، وهو ما يسمّى بـ : الإحساس ، فالمَشْعَر من حيث هو مَشْـعَر منفعل دائماً ، ولو كان له سبحانه مشعر لكان منفعلاً ، والمنفعلِ لا يكون فاعلاً. الصَرد : البرد.
أمّا قوله : « منذ القِدْمة » ، و « قد الأزليّة » ، و « لولا التكملة » ، فمعناه : أنّه يقال في كلّ « مخلوق » : « قد وجد » ، و : « وجد منذ كذا » ; وهذا مانع للقِدَم والأزليّة ، ويقال فيه كذلك : « لولا خالقه ما وجد » ; أي هو ناقص لذاته ، محتاج للتكملة بغيره.
وبعد هذا التقديم ، يتّجه النصّ إلى بثّ المضمون الزهديّ الواعظ :
«... أين تذهبُ بكم المذاهبُ ، وتتيهُ بكم الغياهبُ ، وتَخدعكُم الكواذبُ ؟! ومن أين تُؤْتَوْن ، وأنّى تُؤفَكُوْن ؟! فلكلِّ أجل كتاب ، ولكلِّ غيبة إياب ، فاستمعِوا من ربّانيِّكم... » [١٣].
استمدّ نهج البلاغة أفكاره الفلسفيّة ، ومضامينه الدينية ، ودعواته الزهديّة من بعض ما بشّر به القرآن الكريم ; والتي من بينها الدعوة إلى التوبة ، التي وعد الله أن تكون مكافأتها المغفرة والنجاة من الخطايا والذنوب ، وغالباً ما ترتبط دعوة النهج إلى التوبة بالتشجيع على الاتّصاف بصفات الحذر ، والتخلّي عن الغفلة ، والانتباه إلى قِصَر العمر ; فالموتُ آت وحينذاك لا ينفع إلاّ صالح الأعمال ، الذي إن فات على المرء عمله ، فليَلذ إلى ربّه ويتُب ، ويطلب العفو والصفح قبل فوات الأوان.
ويلمس قارئ نهج البلاغة دعوات التنفير من الدنيا ، والهروب إلى الله ، في مضامين الزهد كلّها التي وقع حديثنا عليها ، أو التي لم يقع عليها بعد ، وبدا من خلال ذلك كلّه أنّ قدرة الإنسان على كبح جماح نفسه ، ولجم نزواتها عن ملذّات الدنيا المحرّمة والمكروهة ، وهي الضمان الفريد لكسب مرضاة الله... وعلى المرء ألاّ يقنط من رحمته ، وإن كثرث ذُنوبه ، على أن يقترن ذلك الإحساس بصحوة الضمير ، والاعتراف بالخطأ ، والشـعور بالندم ، والتصميم على اللاّعودة إلى ارتكاب المعاصي ، وتلك هي التوبة..
« فأفِق أُيّها السامع من سَكْرَتِك ، واستيقِظ من غفلتِك ، واختصرْ من عَجَلَتِكَ ، وأنْعِمِ الفِكْرَ في ما جاءَك على لسان النبيّ الأُمّيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ممّا لا بُدّ منه ، ولا مَحِيْصَ عنه ، وخالِفْ ذلك إلى غيره ، ودَعْهُ وما رضي لنفسِه ، وضَعْ فَخْرَك ، واحطُطْ كِبْرَك ، واذكُرْ قَبْرَكْ ; فإنّ عليه ممرّك. وكما تدِينُ تُدانُ ، وكما تزرعُ تحصُدُ ، وما قدّمتَ اليومَ تَقْدِم عليه غداً ، فامْهَدْ لِقَدَمِكَ ، وقَدِّمْ ليومك.
فالحذرَ الحذر أيُّها المُسْتَمْتِعُ ! والجِدَّ الجِدَّ أيّها الغافل ; ( ولا يُنْبِّئُكَ مِثْلُ خَبير ) [١٤] » [١٥]..
« فطوبى لذي قَلْب سليم ، أطاعَ مَنْ يهديِه ، وتجّنبَ مَن يُرْدِيه ، وأصاب سبيلَ السلامةِ مَنْ بَصَّرَه ، وطاعةِ هاد أمَرَه ، وبادَرَ الهدى قبل أن تُغْلَقَ أبوابُه ، وتُقطَّعُ أسبابُه ، واستفتحَ التوبةَ ، وأماطَ الحَوبةَ ، فقد أُقيمَ على الطريقِ ، وهُدِيَ نهجَ السبيل » [١٦] .
ويأتي بثُّ مجموعة من البديهيّات الدينيّة المتوافقة مع السلوك العبادي ، والمنهج الديني ، مثل : التوكّل على الله عزّ وجلّ توكّلاً صادقاً ، والرجاء لرحمته الواسعة ، والقناعة والرضا بما قسمهُ جلّ وعلا ; متساوقاً تمام التساوق مع أنماط المضامين الزاهدة المبثوثة في كتاب نهج البلاغة.
فالقناعة ، هنا ، قائمة على فلسفة إيمانيّة ، أساسها رفض الدنيا الدنيّة ، وعمودها إيمان مطلق بما في يد الله تعالى;إذ «لا يكون المؤمنُ مؤمناً حتّى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده » [١٧]..
وذلك لأنَّ « الدنيا دارٌ مُنِيَ لها الفَناءُ ، ولأهِلها منها الجلاء ، وهي حُلوةٌ خَضِـرة ، وقد عَجِلَتْ للطالب ، والتَبَسَتْ بقلبِ الناظر ; فارتَحلوا منها بأحْسَنِ ما بحضرِتكم من الزاد ، ولا تسألوا فيها فرقَ الكَفاف ، ولا تطلُبوا منها أكثر من البلاغ » [١٨] .
فالتجلّي الملموس في جملة الأداءات المضمونية الزاهدة التي عرضناها يتيح للمتلقّي الوقوف على نمط النموذج الإنساني الذي يتمنّاه نهج البلاغة ، وهو نموذج لا يرضى أن تتساوى الحياة مع الموت في عمله وعقله وشـعوره ، بل إنّه لا ينظر إلى أهمّية الحياة ، ولا يضع لها قيمة دون أن تكون سبيلاً يمكّن الإنسانَ الفوزَ بمقعد محترم في الحياة التي تليها.
المصادر :
١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ، المسمّى : تاريخ الطبري ، لأبي جعفر محمّد ابن جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ ) ، عزّ الدين للطباعة والنشر / بيروت ، ١٩٨٥ م.
٢ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ( ت ٤٣٠ هـ ) دار الكتاب العربي / بيروت ، ١٩٨٠ م.
٣ ـ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، لأحمد بن شعيب النسائي ( ت ٣٠٣ هـ ) ، تحقيق أحمد ميرين البلوشي ، مكتبة المعلاّ / الكويت ، ١٤٠٦ هـ.
٤ ـ الزهد وصفة الزاهدين ، لأحمد بن محمّد بن زياد بن درهم ( ت ٣٤٠ هـ ) ، تحقيق مجدي فتحي السيّد ، دار الصحابة / طنطا ، ١٤٠٨ هـ.
٥ ـ سنن الترمذي لمحمّد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ٢٧٩ هـ ) ، دار إحياء التراث العربي / بيروت ، بدون تاريخ.
٦ ـ شرح « نهج البلاغة » ، مجموع ما اختاره الشريف الرضيّ ، أبي الحسن محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي ( ت ٤٠٦ هـ ) من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لابن أبي الحديد ( ت ٦٥٦ هـ ) ، بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل / بيروت ، ١٤٠٧ هـ.
٧ ـ شرح « نهج البلاغة » ، للشيخ محمّد عبده ، تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة الاستقامة / مصر. بدون تاريخ.
٨ ـ صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري ( ت ٢٦١ هـ ) ، دار الفكر / بيروت ، ١٩٧٨ م.
٩ ـ الطبقات الكبرى ، لابن سـعد ( ت ٢٣٠ هـ ) ، بيروت ، بدون تاريخ.
١٠ ـ فضائل الصحابة ، لأحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ،مؤسّـسة الرسالة / بيروت ، ١٩٨٣ م.
١١ ـ الفلسفة الصوفية في الإسلام ،د. عبد القادر محمود ،دار الفكر العربي / مصر ، ١٩٦٦ م.
١٢ ـ كتاب الزهد الكبير ، لأبي بكر البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ) ، تحقيق عامر أحمد حسين ، مؤسّـسة الكتب الثقافية / بيروت ، ١٩٩٦ م.
١٣ ـ لسان العرب ، لابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم الإفريقي المصري ، دار صادر / بيروت ، ٢٠٠٠ م.
١٤ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، للمسعودي ، علي بن الحسين ( ت ٣٤٦ هـ ) ، تحقيق محمّد محي الدين عبد المجيد ، دار التحرير / مصر ، ١٩٦٦ م.
١٥ ـ المصنّف في الأحاديث ، لمحمّد بن أبي شيبة الكوفي العبسي ( ت ٢٣٥ هـ ) ، سلسلة مطبوعات الدار السلفية / بومباي ـ الهند ، بدون تاريخ.
١٦ ـ المناقب ، لأحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني ( ت ٤١٠ هـ ) ، دار الحديث للطباعة والنشر / قم ، ١٤٢٢ هـ .
إنتهى .