
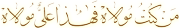
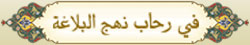


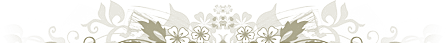

وفيما يلي تفصيل لهذه الطبقات:
الطبقة الاولى: طبقة الجند وهم حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلاَ بهم[١]، ولا تقوم طبقة الجند إلا بما يُخرج الله لهم من الخراج وكذلك بالتعاون مع الطبقات الأخرى (القضاء والعمال والكتاب والتجار وذوو الصناعات)[٢].
ويتم اختيار قادة الجند ورؤسائهم من الذين هم أنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطيء عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف ولا يعقد به الضعف (أي العجز)، ومن ذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ومن أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة[٣] وعلى الوالي أن يؤثرمن قادة الجند ورؤسائهم من واساهم في معونته وأفضل عليهم من جِدَته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلُوف أهليهم حتى يكون همهم واحداً في جهاد العدو[٤].
أي على الوالي أن يؤثر من هؤلاء القادة من تميز بمساعدته لجنده ومن أفاض عليهم مما لديه من الارزاق والغنائم كي يستطيعوا التفرغ لقتال العدو دون أي عبء آخر من أعباء الحياة المتصلة بعائلاتهم وذويهم.وأنظر: أبن أبي الحديد. مصدر سابق، مجلد ٥، ص ٣٨ – ٤٠.
الطبقة الثانية: طبقة الكتّاب وهم الكتبة العاملون في الوظائف العامة كالمحاسبين والمحررين، أو المختصون بالحاكم[٥].
ويرى ابن أبي الحديد أن الكاتب الذي يشير إليه الإمام علي (عليه السلام) في عهده هذا هو الذي يسمى الآن في الاصطلاخ العرفي وزيراً، لأنه صاحب تدبير حضرة الامير (أمير المؤمنين) والنائب عنه في أموره، وإليه تصل مكتوبات العمال وعنه تصدر الأجوبة[٦].
ويتم اختيار الكتاب من بين اولئك الذين سبقوا أن اختبروا في وظائفهم هذه ولدى حكام سالفين فبرهنوا عن جدارة وأمانة وسمعة حسنة، ولا يكون اختيارهم بالفراسة والاستنامة (أي السكون والثقة) فقط، لأن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنّعهم وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء[٧]، وعلى الحاكم أن يختار من بين هؤلاء الكتّاب خيرهم و أجمعهم لوجود صالح الأخلاق (أي الذين يتحلون بالأخلاق الصالحة) وأولئك الذين لا يبطرهم تكريم الحاكم لهم فيجترئون عليه في مجالسه، أو تقصر بهم الغفلة عن ايراد مكاتبات عماله عليه، فيهملون ايصالها إليه إهمالاً أو عمداً، فيعتمد هؤلاء الكتاب لتعهد رسائله التي تتضمن مكائده وأسراره حيث يكونون مسؤولين عن كتابتها وإرسالها إلى مقاصدها من الولاة والعمال أو الملوك، وغيرهم، وكتابة الأجوبة على ما يرد للحاكم من رسائل صادرة عن هؤلاء الولاة والعمال والملوك وغيرهم.
وخلاصة القول: إن على الكاتب أن يكون، بالإضافة إلى أمانته وكتمانه للسر وحسن تدبيره، خبيراً بمختلف أنواع المعاملات والعقود والمكاتبات، بحيث يجنب الحاكم أي ضرر أو إشكال[٨]، لأنه مهما كان في كتابك من غيب فتغابيت عنه الزمته[٩].
وينصح (عليه السلام) الحاكم أن يجعل على رأس كل دائرة من دوائر أعماله كاتباً من كتّابه، مقتدراً لا يقهره كبيرها أي لا يتجرأ عليه كبير تلك الدائرة فيمنعه من أداء واجبه على الوجه الأكمل وفقاً لتوجيهات الحاكم نفسه، ثم لا يتشتت عليه كثيرها (١٤).
أي لا يخرج معظم أعمال تلك الدائرة عن ضبطه وسلطته[١٠].
الطبقة الثالثة: طبقة القضاء وهم قضاة العدل، ويخُتارون من بين أفضل الرعية ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمكنه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصّر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ويكون أوقف الناس في الشبهات وآخذهم بالحجج، أقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء ، ويستطرد (عليه السلام) بقوله: وأولئك قليل[١١].
وعلى الحاكم أن يكثر من تعاهد القاضي أي استكشافه والتعرفة إلى حقيقته وشخصيته وأخلاقه ومتابعة أحكامه وأن يزيد له في العطاء كي تقل حاجته إلى الناس وأن يخصه بمنزلة تتميز عن منزلة غيره من خاصته رفعة وتقديراً وذلك لكي تهابة العامة والخاصة وتحترمه وتثق بعدالة أحكامه[١٢].
الطبقة الرابعة: طبقة العمال وهم الذين يستعملهم أميرالمؤمنين على مختلف الأمصار والبلدان فيحكمونها باسمه، ويجب أن يتم اختيارهم لمناصبهم هذه اختياراً لا محاباة وإثرة على أن يكونوا من أهل التجربة والحياة ومن أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام وذلك لأنهم أكرم خَلقاَ، وأصح إعراضاً، وأقل في المطامع إشرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً[١٣].
ولكنه، رغم ما يفرضه من حسن اختيار الحاكم أو الخليفة لعمّاله ومراعاة صفات الخبرة والحياة والقدم في الإسلام والخلق الكريم فيهم، فإنه يأمر بما يلي:
أ- الإغداق على العمال بالعطاء فإن في ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم من أموال المسلمين.
ب – وفوق ذلك، مراقبتهم، وتفقد أعمالهم، وبث العيون والرقباء من أهل الصدق والوفاء عليهم، كيلا يفتنوا فيفسدوا.
ج – معاقبة الخائن منهم عقاباً شديداً، وذلك بعد التأكيد من ثبوت خيانته بواسطة شهادات العيون والرقباء، وبجب أن تكون عقوبته في بدنه و بما أصابه من عمله ثم ينصب بمقام المذلة ويوسم بالخيانة ويقلد عار التهمة[١٤].
الطبقة الخامسة: طبقة أهل الجزية والخراج وهم أهل البلاد الذين يكلفون أموال الجزية والخراج، ويرى (عليه السلام) أن أمر الخراج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمار البلاد، فهو ينصح عامله في هذا المجال بقوله: ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقيم أمره إلا قليلاً[١٥].
ويشدد (عليه السلام) على إعمار الأرض والبلاد تأميناً للخراج وحسنا الانتاج، ويأمر عماله أن يخففوا عن الرعية إذا ما ملحت الأرض لسبب من الأسباب مثل انقطاع شرب أو بالّة أو إحالة أرض أغتمرها غرق أو اجحف بها عطش وذلك لأن العمران محتمل ما حملتَه، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، إنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبرة[١٦].
الطبقة السادسة: طبقة التجار وأهل الصناعات ويأمر (عليه السلام) عامله (الأشتر) بأن يستوصى بالتجار وذوي الصناعات ويوصى بهم خيراً، فهم مواد المنافع وأسباب المرافق يجلبونها من أماكن بعيدة المنال ويؤمّنوها للناس من حيث لا يستطيعون هم، بأنفسهم، تأمينها، ويأمره، كذلك، أن يتفقد أمورهم في مختلف أطراف البلاد التي هو مولّى عليها، إلا إنه يحذره (عليه السلام) من أن في الكثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرةٍ للعامة وعيب على الولاة لذا، فهو يأمره أن يمنع هؤلاء من الاحتكار،ويحرص على أن يكون بيعهم بيعاً سمحاً، بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع كما يأمره بالتنكيل بالمحتكرين منهم بعد أن يكون قد نهاهم عن ذلك، وأن يعاقبهم في غير إسراف[١٧].
الطبقة السابعة: وهي الطبقة السفلى، كما يسميها علي (عليه السلام) أو طبقة المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزّمني أي ذوو الفقر المدقع (البؤس) وذوو العاهات المزمنة التي تمنعهم من الاكتساب (الزَّمني).
ويرى (عليه السلام) أن في هذه الطبقة القانعين والمعتّرين (بتشديد الراء أي المعترضين للعطاء بلا سؤال)، و هو يوصي عامله أن يجعل لهؤلاء قسماً من بيت المال وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد[١٨]، وأن يرأف بهم ويتفقد أمورهم،وخاصة أولئك لا يستطيعون الوصول إليه ولا ينشغل عنهم باهتمامات أخرى فأن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الانصاف من غيرهم ، وأن يتعهد اليتامى والمسنين والعاجزين، وأن يعقد جلسة مجلساً عاماً يستقبل فيه أصحاب الشكاوي والمظالم وذوي الحاجات دون أن يحجبهم عنه حراسة وشرطة فيتحدثون إليه دون تعتعة أو رجل، ويستمع إلى شكاواهم وظلاماتهم وحاجاتهم فيحقق فيها ويستجيب للمحق منها ويرفع عن كل مظلوم ما وقع عليه من ظلم فإنه، كما قال رسول الله (صلعم): لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع[١٩].
ثم حدد (عليه السلام) في عهده هذا للاشتر ، الأمور التي يجب عليه مباشرتها بنفسه وهي:
- الكتابة إلى العمال في الأمور التي لا يتستطيع كتّابه الاجابة عليها.
- قضاء حاجات الناس يوم ورودها عليك وذلك كي لا يدع مجالاً لاعوانه في معاطلة أصحاب هذه الحاجات ومساواتهم.
- عدم تأجيل عمل يوم إلى غد، فإن للغد عملاً آخر، ولكل يوم ما فيه.
- إقامة الشعائر الدينية، وإذا أقام الصلاة بالناس فليصل بهم كصلاة أضعفهم لأن فيهم من به العلة وله الحاجة[٢٠].
- وختم (عليه السلام) عهد هذا للاشتر بالنصائح التالية، ونصائح أميرالمؤمنين أوامر يجب أن تطاع:
- عدم الاحتجاب عن الرعية لمدة طويلة.
- عدم استئثارالخاصة والبطانة وتطاولها.
- لزوم الحق والصبر والإحتساب.
- عدم رفض الصلح مع العدو إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.
- الحذرمن العدو حتى بعد الصلح معه.
- المحافظة على العهود والذمم والمواثيق.
- عدم سفك الدماء بغير حق.
- عدم الغرور وعدم حب إطراء والثناء.
- عدم التمنين عند العطاء أو الإخلاف بالوعد.
- عدم التسرع والعجلة.
- عدم الاستثمار والأنانية.
- عدم الغضب[٢١].
٥- ممارسة الحكم
لم يكتفِ الإمام علي (عليه السلام) بتحديد أفكاره، ومفهومه للحكم والولاية في خطبه ورسائله وأقواله التي حفظت عنه في سفره القيم (نهج البلاغة)، وإنما مارس أفكاره تلك و مفهومه هذا في خلال تمرسه بأعباء الخلافة لفترة لم تتعد السنوات الخمس (٣٥ – ٤٠ هـ)، وفيما يلي نماذج من هذه الممارسات.
- في خطبة له (عليه السلام)، خاطب جماهير المسلمين المجتمعة إليه متسائلاً: ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر ؟ وركزت فيكم راية الايمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام ؟ والبستكم العافية من عدلي ؟وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي ؟وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي ؟[٢٢].
وتساؤل الإمام هنا يأتي بمعنى تأكيد حصول الأمر وعدم الشك والالتباس فيه، أي أن جواب عامة الناس المستمعين لهذا التسؤال لابد وأن يكون: بلى.
- وفي خطبة له (عليه السلام) تسمى القاصعة خاطب المسلمين بقوله:
... وأما الناكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاهدت، وأما المارقة فقد دوّخت[٢٣].
ولا شك في أنه (عليه السلام) يرى في فرض الأمن والسلام وقتال الناكثين (أي ناقضي التعهد) والقاسطين (أي الجائرين على الحق) والمارقين (أي الخارجين على الدين) أولى واجبات أي حاكم، في أي زمن، وإن تبدلت مفاهيم الحكم وتطورت.
- وفي كلام له مع طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة:... نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فأتبعه، وما استسن النبي (صلعم) فاقتديته[٢٤] وليس ذلك الإ تعبيراً عن تقيد الحاكم بما نص عليه الدستور الأعظم، القرآن الكريم، وما استند التقليد المتبع في عهد السلف الأكبر، رسول الله (صلعم).
٦- محاسبة الحكام:
وهذه بعض منها:
- كتب (عليه السلام) إلى أحد عمّأله، وقد بلغه أنه تجاوز حدود القانون في حكمه، فقال: بلغني أنك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع حسابك إليّ، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس[٢٥].
- وكتب (عليه السلام) إلى حد عماله، في موضع مماثل، فقال:
... فلما أمكنت الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرّة وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم (الناس) المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزلّ دامية المعزى الكسيرة... ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأزيح الباطل من مظلمتهما[٢٦].
- وكتب (عليه السلام) إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني عامله على أردشير خره (وهي بلدة من بلاد العجم) يقول: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت إمامك: إنك تقسّم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراق قومك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن كان ذلك حقاً لتجدنَّ بك علىّ هواناً، ولتخففنّ عندي ميزاناً،فلا تستهن بحق ربك، ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالاً.
ألا وإن حق من قِبَلك وقِبَلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء يردون عندي عليه ويصدرون عنه[٢٧].
- وكتب (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دُعي إلى وليمة فلبّى الدعوة، قال: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجَلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تُستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفّو وغنيهم مدعو ظن فانظرإلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه[٢٨].
- وأوصى (عليه السلام) ابنيه الحسن والحسين (عليهما السلام) وبني عبد المطلب، لما ضربه ابن ملجم بالسيف ضربة قاتلة، قال: يا بني عبد المطلب، لا الفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلنّ بي إلا قاتلي.
- أنظروا، إذا أنا متٌ، من ضربته فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله (صلعم) يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور[٢٩].
هذا بعض ما ورد من أخبار أمير المؤمنين (عليه السلام) في طريقة ممارسته للحكم.
ثانياً: الفكر العسكري
وكما نتبين من خلال (نهج البلاغة) مفهوم الإمام علي (عليه السلام) للحكم والولاية، نتبين، من خلاله كذلك، فكره العسكري، ولا شك في أن الإمام (عليه السلام)، وإن لم يكن قد برع في الحروب كقائد عسكري، إلا أنه استطاع أن يقدم، من خلال أقواله، نهجاً معيناً في الحرب لا يمكن أهماله أو التغاضي عنه، وفيما يلي نماذج من هذا الفكر:
١- ما يدل على المام واسع بتقنية التعليم الفردي للمقاتل
أ- أوصى (عليه السلام) إبنه محمد بن الحنفية، لمّا أعطاه الراية يوم الجمل، بقوله: عضّ على ناجذك، أعِر الله جمجمتك، تِدْ في الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغضّ بصرك، وأعلم إن النصر من عندالله سبحانه[٣٠].
- النواجذ: أقصى الاضراس او كلها، او الانياب، والناجذ: أحدها، قيل: اذا عض الرجل على اسنانه اشتدت أعصاب رأسه وعظامه، ولهذا يوصى به عند الشدة ليقوى.
- أعز الله جمجمتك: أي ابذل جمجمتك الى الله فلا تسأل عنها، بمعنى: اطلب الشهادة في سبيل الله.
- تِدْ قدمك: من وتد يتد، أي ثبّتها في الأرض كالوتد.
ب - وكان (عليه السلام) يوصي أصحابه عند الحرب بقوله: لا تشتدن عليكم فرّة بعدها كرّة، ولا جولة بعدها حملة، واعطوا السيوف حقوقها، ووطّنوا للجنوب مصارعها، واذمروا انفسكم على الطعن الدعسي والضرب الطلحفي[٣١].
ج - وكان (عليه السلام) يوصي جنده في أيام صفين بقوله:
استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة، وعضّوا على النواجذ فإنه أنبى للسيوف عن الهام، وإكملوا اللامة، وقلقوا السيوف في أغمادها قبل سلّها، والحظوا الخَزَر، واطعُنوا الشَّزَر، ونافحوا بالظّبا، وصلوا السيوف بالخُطا، واعملوا أنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله، فعادوا الكر واستحيوا من الفر، فإنه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب... وأمشوا إلى الموت مشياً سُجُحا، وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنّب، فاضربوا ثَبَجه...[٣٢].
- ارم ببصرك اقصى القوم: أي أحط ببصرك القوم جميعهم وأحص عليهم حركاتهم.
- غضَ النظر: أي غض الطوف عما يخفيك منهم فلا يهولنك منهم هائل، (ص ٤٣ حاشية ٤ – ٦)
وأنظر: ابن أبي الحديد، مصدر سابق، مجلد ١، ص ١٩٩ - ٢٠٠.
- ولا تشتدن عليهم.. حمله أي لا يشق عليكم الامر اذا انهزمتم ثم عدتم بعدها للهجوم.
- وطئوا للجنوب مصارعها: أي مهدوا للجنوب اماكن سقوطها، والجنوب: جمع جنب.
- اذمروا انفسكم: اي احرصوا.
- الطعن الدعسي: الطعن الشديد.
- الطعن الطلحفي: اشد الضرب (ص ١٦ حاشية ١ – ٣).
استبشروا الخشية: اي البسوا خوف الله. وتجلببوا السكينة: اي الهدوء.
- انبىئ، من (نبا) السيف، اذا دفعته الصلابة عن معوقة فلم يقطع، والهام: الرؤوس، (مفردها هامة).
- اكملوا اللامة: اي اكملوا الدروع بان تضيفوا اليها لوازمها.
- قلقوا السيوف: اي هزوها خشية أن تعصى عليكم عند سلها.
- الخَزَر (محركه)، اي النظر كأنه من أحد الشقين، وهو علامة الغضب.
- أطعُنوا الشْزَر، اي اطعنوا في الجوانب يميناً وشمالاً.
- نافحوا: كافحوا، والظّبا: طرف السيف وحده (معروفا ظُبة).
- صلوا السيوف بالخُطا: اي اجعلوا سيوفكم متصلة بخطى أعدائكم، وان قصرت فصلوها بخطاكم (ص ١١٤ حاشية ٢ – ٩).
- سُجُحا (بضمتين): اي سهلاً.
- السواد الاعظم: جمهور أهل الشام. والرواق المطنب: اي رواق معاوية.
- التبَع (بالتحريك): الوسط (ص ١١٥ حاشية ١ – ٥).
- وانظر: ابن أبي الحديد مصدر سابق، مجلد ٢، ص ٢٠٣ – ٢٠٨.
الا أروع ما قاله (عليه السلام) في هذا المجال، ملخصاً، بإبداع مبادىء التعليم الفردي للمقاتل، وهو ما أوصى به جنده قبل القتال، في أحد أيام صفين، أيضاً، قال عليه السلام:
[٣٣]... فقدّموا الدارع وأخَّروا الحاسر وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا على أطراف الرماح فإنه أمْورْ للأسنّة وغضّوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلّوها، ولا تجعلوها، إلا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم، فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفّون براياتهم ويكتنفون حِفَافَيْها: وراءها وأمامها، لا يتأخرون عنها فيسلّمونها، ولا يتقدمون عليها فيفردها[٣٤] وفي ذلك تحريض على حماية المقاتلين لرايتهم والذود عنها، فقد كان سقوط الراية يعني، في ذلك الحين، هزيمة الجيش.
٢- ما يحض على الجهاد ويذم القاعدين عنه
وقال (عليه السلام) في إحدى خطبه عن الجهاد وذم القاعدين عنه: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجُنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل وشملة البلاء... الأ وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً سراً وإعلاناً، وقلت لكم أعزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذُلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شُنت الغارات عليكم ومُلكت عليكم الاوطان... فيا عجباً والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً يُرمى يُغارعليكم ولا تَغيرون، وتُغزون ولا تَغزون، ويُعصى الله وترضون.. يا أشباه الرجال ولا رجال، حُلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت إني لم اركم ولم أعرفكم... قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظاً... وأفسدتم علّي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحروب.
- الدارع: لابس الدرع، والحاسر: من لا درع له.
- التووا: اميلوا جانبكم لتنزلق الرماح ولا تنفذ فيكم اسنتها.
- أمْوَر: اشد فعلاً للمور وهو اضطراب الموجب للانزلاق وعدم النفوذ.
- الذّمار: ما يلزم الرجل حفظه وحمايته من ماله وعرضه.
- الحقائق: جمع حاقة وهي النازلة الثابتة، وحفافَيْها: جانبيها (ص – ٣ حاشية ١ – ٥). وعند ابن أبي الحديد ويكتنفونها حفافَيْها، ووراءها وامامها... وهو الاصح لغوياً انظر: ابن أبي الحديد مصدر سابق، مجلد ٢، ص ٧٩٧ - ٧٩٨.
لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها أنذا قد ذرّفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يُطاع[٣٥].
- وقال في خطبة أخرى، يخاطب جماعته: تقولون في المجالس كيت وكيت، فاذا جاء القتال قلتم حيدي حِياد... أيّ دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون. المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخْيَب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوقَ ناصل، أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم[٣٦].
وقال في خطبة أخرى، وهو يحض انصاره على القتال:
أين القوم الذين عادوا إلى الاسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن فأحكموه، وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى اولادها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصفاً صفاً[٣٧]، وقال أيضاً، متوعداً خصومه: انهم لن يزولوا عن مواقفهم... حتى يُرموا بالمناسر تتبعها المناسر، ويُرجَموا بالكتائب تقفوها الحلائب، وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم[٣٨].
وانظر: الثعالبي، فقه اللغة، (القاهرة: مطبعة الاستقامة، د. ت)، ص ٣٢٩.
جُنته (بالضم): أي وقايته (ص ٦٧ حاشية ٤).
- ترحا: هماً وحزناً (ص ٦٩ حاشية ٤).
- ربات الحجال: النساء.
- ذرَّفتُ: زدت (ص ٧٠ حاشية ١ و ٥). وانظر: ابن أبي الحديد، مصدر سابق، مجلد ١، ص ٣٢٧ – ٣٣١.
- حيدي جياد: كلمة يقولها الهارب كأنه يسأل الحرب أن تتنحى عنه.
- السهم الاخيب: اي الذي لاحظ له باصابة الهدف.
- السهم الافوق: اي مكسور الفَوْق وهو موضع الوتر منه. والناصل: العاري عن النصل. والمعنى: ان رمى بكم فكأنما رمى بسهم لا يثبت في الوتر حتى يُرمى، وان رمى به لم يصّب مقتلاً اذ لا نصل له. (ص ٧٤ حاشية ١ – ٥). وانظر: ابن أبي الحديد، مصدر سابق، مجلد ١، ص ٣٥٣ – ٣٥٤.
٢- ما يحدد الصفات التي يجب ان تتوافر في القائد والمقاتل
أ- صفات القائد: أن يكون رجلاً محارباً من أهل البلاء والتجربة والمشورة، لايخشى سقوطه وضعفه، ولا يبطىء عندما يلزم الاسراع أو يسرع عندما يلزم الإبطاء.
- أن يكون ذا منزلة عند الجند بمساعدته لهم وحدبه عليهم، وأن يكون نصوحاً، نقي الجيب، حليماً، يرأف بالضعفاء ويقوى على الأقوياء.
- وقد حدد (عليه السلام) هذه الصفات في مواضع عدة:
الأول: عندما استشاره الخليفة عمر (رضي) في حربه مع الروم وهل يخرج إليهم بنفسه فأشار عليه بما يلي: إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتُنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجلاً مِحرباً واحفِز معه أهل البلاد والنصيحة، فإن أظهر الله لك فذاك ما تحب، وأن تكن الاخرى كنت رداءاً للناس ومثابة للمسلمين[٣٩].
والثاني: في كتاب منه (عليه السلام) الى اميرين من امراء جيشه ، حيث قال لهما: وقد امرت عليكما وعلى من في حيزكما مالك بن الحارث الاشتر ، فاسمعا له واطيعا ، واجعلاه درعا ومجنا ، فانه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عما لالاسراع اليه احزم ، ولا اسراعه الى ما البطء عنه امثل[٤٠].
او هو الجيش الكبير المؤلف من خمسة اقسام: مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة، ولذا سمي خميساً (المؤلف). ودعق الطريق:وطئها وطئاً شديداً، والمسارب: مذاهب الرعي (حاشية ٩).
- كانفة: عاصمة يلجأون اليها.
- ردءاً: ملجأ.
- مِحَربا: اي محارباً.
- مثابة: اي مرجعاً. (ص ١٨ حاشية ٢ – ٤).
- حيّزكما: مقر سلطتكما.
- مجنّاً: ترساً. (ص ١٤ حاشية ٢ و ٣).
والثالث: في عهده (عليه السلام) للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها، إذ كتب إليه يقول: فوَّل من جندك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك، وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطىء عن الغضب، ويستريح إلى العذر، ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء، ومن لا يثيره العنف ولا يعقد به الضعف، ثم الصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشُعَبٌ من العُرْف، ثم تفقد من أمورهم ما ينتقده الولدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به ولا تَحقرِن لطفاً تعهدتهم به[٤١].
ويتابع (عليه السلام) في العهد نفسه: وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خُلوف اهليهم حتى يكون همهم واحداً في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية.
ب – صفات والاختيار:
- الطاعة والاندفاع وعدم التخاذل والتقاعس.
- الذود عن الدين، والحفاظ على الأمن والرعية، والاخلاص للولاة.
وقد حدد (عليه السلام) ذلك في أوامره إلى بعض قادة جيشه، فقال: فإن عادوا (اي أعداؤك) إلى ظل الطاعة فذلك الذي نحب، وإن توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان، فأنهد بمن أطاعك إلى من عصاك واستغنِ بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك، فإن المتكاره مغيبه خير من شهوده، وقعوده أغنى من نهوضه[٤٢].
كما خصّ (عليه السلام) الجنود بالوصف التالي: فالجنود باذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود، إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقودون به في جهادهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجاتهم[٤٣].
- نقي الحبيب: طاهر الصدر والقلب.
- ينبو على الاقوياء: يشتد عليهم ويمنعهم عن ظلم الضعفاء.
- الصق بذوي الاحساب: تبيين للقبيل الذي يؤخذ منه الجند ويكون منه رؤساؤه.
- شُعَب: جمع شعبة، والعُرف: المعروف (ص ٩١ – حاشية ٢ – ٤).
- لا يتفاقمن في نفسك شيء قوّيتهم به: اي لا تعدَ شيئاً قويتهم به زائداً عما يستحقون، فكل شيء قويتهم به واجب عليك وهم يستحقونه (ص ٩٢ حاشية ١).
- المصدر نفسه، ج ٣، ص ٩٢.
- الجَدة: السعة والغنى.
- الخلوف: مفردها خَلف، وهو من يبقى في الحمى من النساء والعجزة بعد سفر الرجال (ص ٩٢ حاشية ٣)، وقد سبق وذكرنا ذلك في حديثنا عن طبقة الجند.
٤ – ما يحدد آداب القتال
وذلك في وصيته (عليه السلام) لجنده قبل صفين إذ قال: لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فانكم بحمد الله على حجّة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجةُ أخرى لكم عليهم، فاذا كانت الهزيمة باذن الله فلا تقتلوا مُدْبِرا ولا تصيبوا مُغورا ولا تجهزوا على جريح ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول[٤٤].
٥ – ما يحدد أسس اختيار بقعة نزول الجيش والحذر في المعسكر
وذلك في وصيته (عليه السلام) إلى بعض قادة جيشه، إذ قال: فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قُبيل الإشراف أو سفاح الجبال، أو أثناء الأنهار كيما يكون لكم رداءا ودونكم مرّدأ، ولتكن مقاتلتكم من وجهٍ واحدٍ او اثنين. وأجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكب الهضاب لئلا يأتيكم العدو من كان مخافةٍ أو أمن. وأعلموا أم مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم. وإياكم والتفرق، فاذا نزلتم فانزلوا جميعاً، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كِفة ولا تذوقوا النوم إلا غِراراً أو مضمضة[٤٥].
- يكون من وراء حاجتهم: اي يكون محيطاً بجميع حاجاتهم دافعاً لها. (ص ٩٠ حاشية ٢).
- الاشراف: جمع شرف، اي العلو وقُبيل الاشراف: اي قدّام الجبال. (ص ١٢ حاشية ٤)، ووجه اي جهة، والمقصود أن يكون تمركز الجيش في إعالي الجبال أو سفوحها، وفي منعطفات الانهار، وان لا يقاتلوا إلا من جهة أو اثنتين.
- صياصي: أعالي.
- مناكب: مرتفعات.
- أجعلوا الرماح كِفّة: اي أجعلوها مستدبرة حولكم كأنها كِفة الميزان.
- الغِرار (بكسر الغين): النوم الخفيف. و المضمضة: ان ينام ثم يستيقظ تشبيهاً بمضمضة الماء في الفم يأخذه ثم يمجه (ص ١٣ حاشية ١ و ٢).
٦ – ما يحدد السلوك الواجب اتباعه في السير نحو العدالة
وذلك في وصيته (عليه السلام) لمعقل بن قيس الراحي حين أنفذه إلى الشام للقتال بجيش عديدة ثلاثة آلاف مقاتل، قال: لا تقاتلن إلا من قاتلك، وسرالبرَدين وغوّر بالناس ورفّه بالسير، ولا تسر أول الليل فإن الله جعله سكناً وقدره مقاماً ولا ظَعْناً فأرِح فيه بدنك وروَّح ظهرك، فاذا وقفت حين ينبطح السحر أو حين ينفجر فسر على بركة الله، فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاً، ولا تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب الحرب، ولا تباعد عنهم من يهاب البأس، حتى ياتيك أمري، ولا يحملنّكم شنانهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار اليهم[٤٦].
٧- ما يحدد سلوك الجيش في البلدان التي يمر فيها
وذلك في كتابه (عليه السلام) إلى جباة الخراج وعمال البلاد التي مر بها جيشه، قال: أني قد سيّرت جنوداً هي مارة بكم إن شاءالله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ اليكم وإلى ذمتكم من معرّة الجيش إلا من جَوْعة المضطر لا يجد عنها مذهباً إلى شبعه، فنكّلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضادتهم والتعرض لهم فيما استثنياه منهم، وأنا بين أظهر الجيش فادفعوا إليّ مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم ولا تطيقون دفعه إلا بالله وبي فأنا أغيّره بمعونة الله إن شاء الله[٤٧].
كما قال في حديث آخر له وهو يشيع جيشاً ارسله في غزو: اعذبوا عن النساء ما استطعتم[٤٨].
وأنظر: ابن أبي الحديد، مصدرسابق، مجلد ٥، ص ص ٥٤٤ - ٥٤٥.
- الشذى: الشر.
- معرّة: اذى.
- الا من جَوْعة المضطر لا يجد عنها مذهباً الى شيعة: اي انه يستثنى حالة الجوع المهلك فان للجيش فيها حقاً ان يتناول ما يسد رمقه.
- نكلوا من تناول منهم شيئاً ظلما عن ظلمهم: اي اوقعوا النكال والعقاب بمن تناول شيئاً من اموال الناس وهو غير مضطر.
- فيما استثنيناه منهم: اي حالة الاضطرار.
- انا بين اظهر الجيش فادفعوا اليّ مظالمكم: اي إنني موجود فيه، فما عجزتم عن دفعة فردوه الى اكفكم ضرّه و شره (ص ١١٧ حاشية ١ – ٥). (ملاحظة ؟) ابن أبي الحديد، مصدر سابق، مجلد ٥، ص ١٠٧ – ١٠٨.
٨ – ما يحدد سلوك الرئيس تجاه مرؤوسيه
وذلك في كتاب منه (عليه السلام) إلى قادته أصحاب المسالحة قال: لكم عندي أن لا احتجز دونك سراً إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم، ولا أوْخر لكم حقاً عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق، فإن أنتم لم تستقيموا على ذلك لم يكن أحد أهون عليّ ممن أعوج منكم، ثم أعظم له العقوبة، ولا يجد فيها عندي رخصة، فخذوا هذا من أمرائكم، واعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم[٤٩].
وهو (عليه السلام) يلوم أحد قادته (كميل بن زياد النخعي، عامله على هيت) وينكر عليه تجاوزه مهمته في الدفاع عن المسالح بالاغارة على قرقيسيا، فيكتب إليه قائلاً: إن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا، وتعطيلك مسالحك التي وليناك، ليس بها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها، لرأي شعاع، فقد صرتَ جسراً لمن أراد الغارة من اعدائك على اوليائك، غير شديدِ المنكب ولا مهيب الجانب ولا سادِ ثُغرة، ولا كاسرٍ شوكة ولا مغنٍ عن أهل مصرِه ولا مجزِ عن اهل مصره ، ولا مجز عن أميره[٥٠].
- لا احتجز دونكم سراً الا في حرب: اي الاّ اكتم عنكم سراً إلا في حرب، لأن الحرب خدعة.
- لا اطوي دونكم امراً الإ في حكم: اي ولا أدع مشاورتكم إلا في حكم صرح به الشرع.
- دون مقطعه: اي دون الحد الذي قُطع به أن يكون لكم.
- لا تنكصوا عن دعوة لا تتأخروا اذا دعوتكم (ص ٧٩ حاشية ٣ – ٦).
- الغَمَرات: الشدائد، (ص ٨٠ حاشية ١). وانظر: ابن أبي الحديد، مصدر سابق، مجلد ٥، ص ١٣ - ١٤.
- قرقيسيا: بلد على الفرات.
- المسالح: جمع مسلحة، اي الثغور ومواضع السلاح، وهي، هنا، مواضع الحامية على الحدود.
- رأي شعاع (بفتح الشبين): رأي متفرق وليس برأي صالح مجمع عليه.
- غير شديد المنكب: اي ضعيف.
- غير مغن عن أهل مصره:اي غير قادرعلى حماية اهل المصر من غارات الاعداء(ص ١١٨ حاشية ١ – ٣).
٩ – ما يدعو إلى الاعداد للحرب والمصابرة وتعاون الجند فيما بينهم في اثناء القتال
قال (عليه السلام) في إحدى خطبه داعياً أنصاره للاعداد للقتال والمصابرة:
خذوا للحرب أهبتها، وادعوا لها عدتها، فقد شب لظاها وعلا سناها، واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر[٥١].
وقال في خطبة أخرى داعياً جنده إلى التعاون فيما بينهم والتّازر في اثناء القتال: وأي امريء منكم أحسّ من نفسه رباطة جأش عند اللقاء، ورأي من أحد إخوانه فشلاً، فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فُضَّل بها عليه كما يذب عن نفسه[٥٢].
وقال: إن أكرم الموت القتل[٥٣].
هذا بعض النماذج من فكر الإمام علي (عليه السلام) في الحكم والحرب، استطعنا استنتاجه من نصوص الخطب والرسائل التي القاها (عليه السلام) على ولاته وعماله وقادة جيوشه أو بعثها إليهم، في مناسبات مختلفة، وتضمنها ما جمعه الشريف الرضي في الكتاب الخالد القيّم نهج البلاغة.