
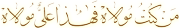
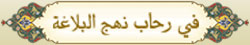


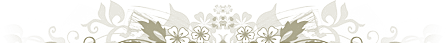

الإمام الباقر والإمام الصادق: إنّ أمير المؤمنين لمّا فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزطّ[١] فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم[٢].
الإمام الصادق : أخرج [يهوديّ] من قبائه كتاباً فدفعه إلي أمير المؤمنين ففضّه ونظر فيه وبكي، فقال له اليهودى: ما يبكيك يا بن أبى طالب ؟ إنّما نظرت فى هذا الكتاب وهو كتاب سريانى وأنت رجل عربى، فهل تدرى ما هو ؟
فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم، هذا اسمى مثبت.
فقال له اليهودى: فأرنى اسمك فى هذا الكتاب، وأخبرنى ما اسمك بالسريانيّة ؟
قال: فأراه أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه فى الصحيفة وقال: اسمى إليا[٣].
عنه : إنّ أمير المؤمنين حين أتي أهل النهروان نزل قَطُفْتا[٤]، فاجتمع إليه أهل بادرويا[٥]، فشكوا ثقل خراجهم، وكلّموه بالنبطية، وأنّ لهم جيراناً أوسع أرضاً وأقلّ خراجاً، فأجابهم بالنبطية: وغرزطا من عوديا.
قال: فمعناه: ربّ رجز صغير خير من رجز كبير[٦].
المناقب لابن شهر آشوب: روى أنّه قال [عليّ] لابنة يزدجرد: ما اسمك ؟ قالت: جهان بانويه. فقال: بل شهر بانويه. وأجابها بالعجميّة[٧].
الخرائج والجرائح عن ابن مسعود: كنت قاعداً عند أمير المؤمنين فى مسجد رسول الله إذ نادي رجل: من يدلّنى علي من آخذ منه علماً ؟ ومرّ.
فقلت له: يا هذا، هل سمعت قول النبىّ : أنا مدينة العلم وعلىّ بابها ؟
فقال: نعم. قلت: وأين تذهب وهذا علىّ بن أبى طالب ؟ فانصرف الرجل وجثا بين يديه. فقال له: من أىّ بلاد الله أنت ؟ قال: من أصفهان. قال له: اكتب: أملي علىّ بن أبى طالب ... قال: زدنى يا أمير المؤمنين. قال ـ باللسان الأصفهانى ـ: أروت إين وس. يعنى اليوم حسبك هذا[٨].
عيون أخبار الرضا عن أبى الصلت الهروى: كان الرضا يكلّم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكلّ لسان ولغة، فقلت له يوماً: يا بن رسول الله إنّى لأعجب من معرفتك بهذه اللغات علي اختلافها !
فقال: يا أبا الصلت أنا حجّة الله علي خلقه، وما كان الله ليتّخذ حجّة علي قوم وهو لا يعرف لغاتهم، أو ما بلغك قول أمير المؤمنين : اُوتينا فصل الخطاب ؟ فهل فصل الخطاب إلاّ معرفة اللغات ؟[٩]
راجع:كتاب "أهل البيت فى الكتاب والسنّة" / علم أهل البيت / أبواب علومهم / جميع اللغات.
سير أعلام النبلاء عن أبى الأسود: دخلت علي علىّ فرأيته مطرقاً، فقلت: فيم تتفكّرُ يا أمير المؤمنين ؟
قال: سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً فى اُصول العربيّة.
فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا. فأتيته بعد أيّام، فألقي إلىَّ صحيفة فيها:
الكلام كلّه: اسم، وفعل، وحرف، فالاسم: ما أنبأ عن المسمّي، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمّي، والحرف: ما أنبأ عن معني ليس باسم ولا فعل. ثمّ قال لى: زده وتتبّعه. فجمعت أشياء ثمّ عرضتها عليه[١٠].
تاريخ الخلفاء عن أبى الأسود الدؤلى: دخلت علي أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (ع) فرأيته مطرقاً مفكّراً، فقلت: فيم تفكّر يا أمير المؤمنين ؟
قال: إنّى سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً فى اُصول العربيّة.
فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا، وبقيت فينا هذه اللغة.
ثمّ أتيته بعد ثلاث، فألقي إلىَّ صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة: اسم، وفعل، وحرف، فالاسم: ما أنبأ عن المسمّي، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمّي، والحرف: ما أنبأ عن معني ليس باسم ولا فعل.
ثمّ قال: تتبّعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود، أنّ الأشياء ثلاثة:
ظاهر، ومضمر، وشىء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنّما يتفاضل العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر.
قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها: إنّ وأنّ وليت ولعلّ وكأنّ، ولم أذكر لكنّ، فقال لى: لِمَ تركتها ؟
فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بلي هى منها، فزدها فيها[١١].
شعب الإيمان عن صعصعة بن صوحان: جاء أعرابى إلي علىّ بن أبى طالب، فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، كيف تقرأ هذا الحرف "لا يأكله إلاّ الخاطون" كلٌّ والله يخطو ؟
فتبسّم علىّ (ع) وقال يا أعرابى: لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئـُونَ[١٢]
قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين، ما كان الله ليسلم عبده.
ثمّ التفت علىّ إلي أبى الأسود الدؤلى فقال: إنّ الأعاجم قد دخلت فى الدِّين كافّة، فضع للناس شيئاً يستدلّون به علي صلاح ألسنتهم، فرسم له الرفع والنصب والخفض[١٣].
المناقب لابن شهر آشوب: وهو [الإمام علىّ ] واضع النحو ; لأنّهم يروونه عن الخليل بن أحمد بن عيسي بن عمرو الثقفى عن عبد الله بن إسحاق الحضرمى عن أبى عمرو بن العلاء عن ميمون الأفرن عن عنبسة الفيل عن أبى الأسود الدؤلى عنه .
والسبب فى ذلك: إنّ قريشاً كانوا يزوّجون بالأنباط[١٤] فوقع فيما بينهم أولاد ففسد لسانهم، حتي إنّ بنتاً لخويلد الأسدى كانت متزوّجة بالأنباط، فقالت: إنّ أبوى مات وترك علىّ مالٌ كثيرٌ. فلمّا رأوا فساد لسانها أسّس النحو.
وروى أنّ أعرابياً سمع من سوقى يقرأ: "إنَّ اللهَ بَريءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِه"[١٥] فشجّ رأسه، فخاصمه إلي أمير المؤمنين، فقال له فى ذلك، فقال: إنّه كفر بالله فى قراءته.
فقال : إنّه لم يتعمّد ذلك.
وروى أنّ أبا الأسود كان فى بصره سوءٌ، وله بنيّة تقوده إلي علىّ ، فقالت: يا أبتاه، ما أشدُّ حرِّ الرمضاء ! تريد التعجّب، فنهاها عن مقالتها، فأخبر أمير المؤمنين بذلك فأسّس.
وروى أنّ أبا الأسود كان يمشى خلف جنازة، فقال له رجل: مَن المتوفّى ؟
فقال: الله، ثمّ أخبر عليّاً بذلك فأسّس.
فعلي أىّ وجه كان وقعه إلي أبى الأسود وقال: ما أحسن هذا النحو !، احشِ له بالمسائل، فسمّى نحواً[١٦].
تاج العروس: إنّ أوّل من رسم للناس النحو واللغة أبو الأسود الدؤلى، وكان أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (ع)[١٧].
تاج العروس ـ فى بيان الأقوال فى وجه تسمية علم النحو بهذا الاسم ـ: قيل: لقول علىّ رضى الله تعالي عنه بعدما علّم أبا الأسود الاسم والفعل وأبواباً من العربيّة: انحُ علي هذا النحو[١٨].
البداية والنهاية عن ابن خلّكان وغيره: كان أوّل من ألقي إليه علم النحو علىّ بن أبى طالب، وذكر له أنّ الكلام: اسم، وفعل، وحرف. ثمّ إنّ أبا الأسود نحا نحوه، وفرّع علي قوله، وسلك طريقه، فسمّى هذا العلم: النحو، لذلك[١٩].
الإمام علىّ : إنّا لاَمراء الكلام، وفينا تنشّبت[٢٠] عروقه، وعلينا تهدّلت[٢١] غصونه[٢٢].
المناقب لابن شهر آشوب: عن الرضا عن آبائه (ع): إنّه اجتمعت الصحابة فتذاكروا أنّ الألف أكثر دخولا فى الكلام، فارتجل الخطبة المونقة التى أوّلها: حمدتُ من عظمت منّته، وسبغت نعمته، وسبقت رحمته، وتمّت كلمته، ونفذت مشيّته، وبلغت قضيّته... إلي آخرها[٢٣].
ثمّ ارتجل خطبة اُخري من غير النقط التى أوّلها: الحمد لله أهل الحمد ومأواه، وله أوكد الحمد وأحلاه، وأسرع الحمد وأسراه، وأظهر الحمد وأسماه، وأكرم الحمد وأولاه... إلي آخرها[٢٤]. وقد أوردتهما فى المخزون المكنون.
ومن كلامه: تخفّفوا تلحقوا فإنّما ينتظر بأوّلكم آخركم.
وقوله: ومن يقبض يده عن عشيرته فإنّما يقبض عنهم بيد واحدة، ويقبض منهم عنه أيد كثيرة، ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودّة.
وقوله: من جهل شيئاً عاداه، مثله: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ[٢٥].
وقوله: المرء مخبوّ تحت لسانه، فإذا تكلّم ظهر، مثله: وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ[٢٦].
وقوله: قيمة كلّ امرئ ما يحسن، مثله: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ[٢٧].
وقوله: القتل يقلّ القتل، مثله: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ[٢٨] [٢٩].
تاريخ دمشق: قال معاوية: إن كنّا لنتحدّث أنّه ما جرت المواسى[٣٠] علي رأس رجل من قريش أفصح من علىّ[٣١].
الإمامة والسياسة ـ فى ذكر قدوم ابن أبى محجن علي معاوية ـ: قال معاوية: فو الله لو أنّ ألسن الناس جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاها لسان علىّ[٣٢].
مروج الذهب ـ فى ذكر لمع من كلام علىّ ـ: والذى حفظ الناس عنه من خطبه فى سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة يوردها علي البديهة، وتداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً[٣٣].
نثر الدرّ عن محمّد ابن الحنفيّة ـ فى وصف علىّ ـ: كان إذا تكلّم بذّ[٣٤]، وإذا كلم[٣٥] حذّ[٣٦] وهذا مثل قول غيره: كان علىّ إذا تكلّم فَصَل وإذا ضرب قَتَل[٣٧].
الشريف الرضى فى مقدّمة نهج البلاغة:... وسألونى [جماعة من الأصدقاء والإخوان] عند ذلك [أى بعد تأليف كتاب خصائص الأئمّة] أن أبتدئ بتأليف كتاب يحتوى علي مختار كلام مولانا أمير المؤمنين فى جميع فنونه، ومتشعِّبات غصونه: من خطب وكتب ومواعظ وأدب، علماً أنّ ذلك يتضمّن عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينيّة والدنيويّة، ما لا يوجد مجتمعاً فى كلام، ولا مجموعَ الأطراف فى كتاب.
إذ كان أمير المؤمنين مشرَعَ الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه ظهر مكنونها، وعنه اُخذت قوانينها، وعلي أمثلته حذا كلّ قائل خطيب، وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصّروا، وقد تقدّم وتأخّروا ; لأنّ كلامه الكلام الذى عليه مَسحة من العلم الإلهىّ، وفيه عَبقة من الكلام النبوى.
فأجبتهم إلي الابتداء بذلك، عالماً بما فيه من عظيم النفع ومنشور الذكر، ومذخور الأجر، واعتمدت به أن اُبيّن عن عظيم قدر أمير المؤمنين فى هذه الفضيلة، مضافة إلي المحاسن الدثِرَة، والفضائل الجمّة، وأنّه انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأوّلين، الذين إنّما يؤثرُ عنهم منها القليل النادر، والشاذ الشارد.
فأمّا كلامه فهو البحر الذى لا يُساجَل، والجمّ الذى لا يحافل. وأردت أن يسوّغ لى التمثّل فى الافتخار به بقول الفرزدق:
| اُولئك آبائى فجئنى بمثلهم | إذا جمعتنا يا جرير المجامع[٣٨] |
وقال فى ذيل قوله : "قيمة كلّ امرئ ما يُحسنه"، وهى الكلمة التى لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرن إليها كلمة[٣٩].
وقال فى ذيل قوله : "فإنّ الغاية أمامكم، وإنّ وراءكم الساعة تحدوكم. تَخفّفوا تلحقوا، فإنّما يُنتظر بأوّلكم آخرُكم"، أقول: إنّ هذا الكلام لو وزن، بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله ، بكلّ كلام لمالَ به راجحاً، وبرّز عليه سابقاً.
فأمّا قوله : "تخفّفوا تلحقوا" فما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولاً، وما أبعد غورها من كلمة ! وأنقع[٤٠] نطفتها[٤١] من حكمة ! وقد نبّهنا فى كتاب "الخصائص" علي عظم قدرها وشرف جوهرها[٤٢].
وقال فى ذيل الخطبة السادسة عشرة: إنّ فى هذا الكلام الأدني من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، وإنّ حظّ العجب منه أكثر من حظّ العجب به ! وفيه ـ مع الحال التى وصفنا ـ زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان ولا يطّلع فجّها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلاّ من ضرب فى هذه الصناعة بحقّ، وجري فيها علي عرق وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ[٤٣].
ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة: وأمّا الفصاحة فهو إمام الفصحاء، وسيّد البلغاء، وفى كلامه قيل: دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة.
قال عبد الحميد بن يحيي: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثمّ فاضت.
وقال ابن نباتة: حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلاّ سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ علىّ بن أبى طالب.
ولمّا قال مِحفن بن أبى مِحفن لمعاوية: جئتك من عند أعيي الناس، قال له: ويحك، كيف يكون أعيي الناس ! فو الله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره.
ويكفى هذا الكتاب الذى نحن شارحوه دلالةً علي أنّه لا يجاري فى الفصاحة، ولا يباري فى البلاغة. وحسبك أنّه لم يدوَّن لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر ممّا دوّن له، وكفاك فى هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ فى مدحه فى كتاب "البيان والتبيين" وفى غيره من كتبه[٤٤].
وقال فى ذيل الكتاب ٣٥: اُنظر إلي الفصاحة كيف تعطى هذا الرجل قيادها، وتملّكه زمامها، وأعجب لهذه الألفاظ المنصوبة، يتلو بعضها بعضاً كيف تؤاتيه وتطاوعه، سِلسة سهلة، تتدفّق من غير تعسّف ولا تكلّف، حتي انتهي إلي آخر الفصل فقال: "يوماً واحداً، ولا ألتقى بهم أبداً". وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبة، جاءت القرائن والفواصل تارةً مرفوعة، وتارةً مجرورة، وتارةً منصوبة، فإن أرادوا قَسْرَها بإعراب واحد ظهر منها فى التكلّف أثر بيّن، وعلامة واضحة.
وهذا الصنف من البيان أحد أنواع الإعجاز فى القرآن، ذكره عبد القاهر قال: اُنظر إلي سورة النساء وبعدها سورة المائدة، الاُولي منصوبة الفواصل والثانية ليس فيها منصوب أصلا، ولو مزجت إحدي السورتين بالاُخري لم تمتزجا، وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما، ثمّ إنّ فواصل كلّ واحد منهما تنساق سياقة بمقتضي البيان الطبيعى لا الصناعة التكلّفيّة.
ثم انظر إلي الصفات والموصوفات فى هذا الفصل، كيف قال: ولداً ناصحاً، وعاملا كادحاً، وسيفاً قاطعاً، وركناً دافعاً، لو قال: ولداً كادحاً، وعاملا ناصحاً، وكذلك ما بعده لما كان صواباً ولا فى الموقع واقعاً.
فسبحان الله من منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكّة ينشأ بين أهله، لم يخالط الحكماء وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهيّة من إفلاطون وأرسطو ! ولم يعاشر أرباب الحكم الخلقيّة، والآداب النفسانيّة ; لأنّ قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل ذلك، وخرج أعرف بهذا الباب من سقراط. ولم يربّ بين الشجعان ; لأنّ أهل مكّة كانوا ذوى تجارة ولم يكونوا ذوى حرب، وخرج أشجع من كلّ بشر مشي علي الأرض.
قيل لخلف الأحمر: أيّما أشجع عَنبسة وبسطام أم علىّ بن أبى طالب ؟
فقال: إنّما يذكر عَنبسة وبسطام مع البشر والناس لا مع من يرتفع عن هذه الطبقة.
فقيل له: فعلي كلّ حال. قال: والله لو صاح فى وجوههما لماتا قبل أن يحمل عليهما.
وخرج أفصح من سَحبان وقُسّ، ولم تكن قريش بأفصح العرب، كان غيرها أفصح منها، قالوا: أفصح العرب جُرهم وإن لم تكن لهم نَباهة.
وخرج أزهد الناس فى الدنيا وأعفّهم، مع أنّ قريشاً ذوو حرص ومحبّة للدنيا، ولا غرو فيمن كان محمّد مربّيه ومخرجه، والعناية الإلهيّة تمدّه وترفدُه، أن يكون منه ما كان[٤٥]!
وذكر عن شيخه أبى عثمان قال: حدّثنى ثُمَامة، قال: سمعت جعفر بن يحيي ـ وكان من أبلغ الناس وأفصحهم ـ يقول: الكتابة ضمّ اللفظة إلي اُختها، أ لم تسمعوا قول شاعر لشاعر وقد تفاخرا: أنا أشعرُ منك لأنّى أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن عمّه ! ثمّ قال: وناهيك حسناً بقول علىّ بن أبى طالب :
هل من مناص أو خلاص، أو معاذ أو ملاذ، أو فرار أو محار !.
قال أبو عثمان: وكان جعفر يُعجب أيضاً بقول علىّ : أين من جدَّ واجتهد، وجمع واحتشد، وبني فشيّد، وفرش فمهّد، وزخرف فنجّد ؟ !
قال: ألا تري أنّ كلّ لفظة منها آخذة بعنق قرينتها، جاذبة إياها إلي نفسها، دالّة عليها بذاتها ؟ !
قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح قريش.
واعلم أنّنا لا يتخالجنا الشكّ فى أنّه أفصحُ من كلّ ناطق بلغة العرب من الأوّلين والآخرين، إلاّ من كلام الله سبحانه، وكلام رسول الله ; وذلك لأنّ فضيلة الخطيب والكاتب فى خطابته وكتابته تعتمد علي أمرين،هما: مفردات الألفاظ ومركّباتها.
أمّا المفردات: فأن تكون سهلة، سِلسة، غير وحشيّة ولا معقّدة، وألفاظه كلّها كذلك.
فأمّا المركّبات فَحُسنُ المعني، وسرعة وصوله إلي الأفهام، واشتماله علي الصفات التى باعتبارها فُضّل بعض الكلام علي بعض، وتلك الصفات هى الصناعة التى سمّاها المتأخّرون البديع، من المقابلة والمطابقة، وحسن التقسيم، وردّ آخر الكلام علي صدره، والترصيع، والتسهيم، والتوشيح، والمماثلة، والاستعارة، ولطافة استعمال المجاز، والموازنة، والتكافؤ، والتسميط، والمشاكلة.
ولا شبهة أنّ هذه الصفات كلّها موجودة فى خُطبه وكتبه، مبثوثة متفرّقة فى فرش كلامه ، وليس يوجد هذان الأمران فى كلام أحد غيره، فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيها، وأعمل رويّته فى رصفها ونثرها، فلقد أتي بالعجب العُجاب، ووجب أن يكون إمام الناس كلّهم فى ذلك، لأنّه ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضبها ابتداءً، وفاضت علي لسانه مرتجلة، وجاش بها طبعه بديهة، من غير رويّة ولا اعتمال، فأعجب وأعجب !
وعلي كلا الأمرين فلقد جاء مجلّياً، والفصحاء تنقطع أنفاسهم علي أثره. وبحقٍّ ما قال معاوية لمحقن الضبّى، لمّا قال له: جئتك من عند أعيي الناس: يابن اللخناء، أ لعلىٍّ تقول هذا ؟ ! وهل سنّ الفصاحة لقريش غيره ؟ !
واعلم أنّ تكلّف الاستدلال علي أنّ الشمس مضيئة يتعب، وصاحبه منسوب إلي السفَه، وليس جاحد الاُمور المعلومة علماً ضرورياً بأشدّ سفهاً ممّن رام الاستدلال بالأدلّة النظريّة عليها[٤٦].
وقال أيضاً فى ذيل الخطبة ٩١ ـ التى تُعرف بخطبة الأشباح ـ: "إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعقِل" ! إذا جاء هذا الكلام الربّانى واللفظ القدسى بطلت فصاحة العرب وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه نسبة التراب إلي النضار الخالص، ولو فرضنا أنّ العرب تقدِرُ علي الألفاظ الفصيحة المناسبة أو المقاربة لهذه الألفاظ، من أين لهم المادّة التى عبّرت هذه الألفاظ عنها ؟ ! ومن أين تعرف الجاهليّة بل الصحابة المعاصرون لرسول الله هذه المعانى الغامضة السمائية ليتهيّأ لها التعبير عنها ؟ ! أمّا الجاهليّة فإنّهم إنّما كانت تظهر فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة جبال أو فلوات ونحو ذلك.
وأمّا الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إنّما كان منتهي فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة ; إمّا فى موعظة تتضمّن ذكر الموت أو ذمّ الدنيا أو ما يتعلّق بحرب وقتال من ترغيب أو ترهيب، فأمّا الكلام فى الملائكة وصفاتها وصورها وعباداتها وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها له وولهها إليه، وما جري مجري ذلك ممّا تضمّنه هذا الفصل علي طوله فإنّه لم يكن معروفاً عندهم علي هذا التفصيل، نعم ربّما علموه جملة غير مقسّمة هذا التقسيم ولا مرتّبة هذا الترتيب بما سمعوه من ذكر الملائكة فى القرآن العظيم.
وأمّا من عنده علم من هذه المادّة كعبد الله بن سلام واُميّة بن أبى الصلت وغيرهم فلم تكن لهم هذه العبارة ولا قدَروا علي هذه الفصاحة، فثبت أنّ هذه الاُمور الدقيقة فى مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل إلاّ لعلىّ وحده، واُقسم إنّ هذا الكلام إذا تأمّله اللبيب اقشعرّ جلده ورجف قلبه، واستشعر عظمة الله العظيم فى روعه وخلده وهام نحوه وغلب الوجد عليه، وكاد أن يخرج من مُسكه شوقاً وأن يفارق هيكله صبابةً ووجداً[٤٧].
وقال فى ذيل الخطبة ١٠٩: هذا موضع المثل: "فى كلّ شجرة نارٌ، واستمجد المَرْخ والعَفار[٤٨]" الخطب الوعظيّة الحسان كثيرة، ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث:
| محاسن أصناف المغنين جمّةٌ | وما قصبات السبق إلاّ لمعبد |
من أراد أن يتعلّم الفصاحة والبلاغة ويعرف فضل الكلام بعضه علي بعض فليتأمّل هذه الخطبة، فإنّ نسبتها إلي كلّ فصيح من الكلام ـ عدا كلام الله ورسوله ـ نسبة الكواكب المنيرة الفلكيّة إلي الحجارة المظلمة الأرضية، ثمّ لينظر الناظر إلي ما عليها من البهاء والجلالة والرواء والديباجة، وما تحدثه من الروعة والرهبة والمخافة والخشية، حتي لو تليت علي زنديق ملحد مصمّم علي اعتقاد نفى البعث والنشور ; لهدّت قواه وأرعبت قلبه وأضعفت علي نفسه وزلزلت اعتقاده، فجزي الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزي به وليّاً من أوليائه، فما أبلغ نصرته له تارةً بيده وسيفه وتارةً بلسانه ونطقه وتارةً بقلبه وفكره، إن قيل: جهاد وحرب فهو سيّد المجاهدين والمحاربين، وإن قيل: وعظ وتذكير فهو أبلغ الواعظين والمذكّرين، وإن قيل: فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسّرين، وإن قيل: عدل وتوحيد فهو إمام أهل العدل والموحّدين:
| ليس علي الله بمُستنكر | أن يجمع العالمَ فى واحدِ[٤٩] |
وقال فى ذيل الخطبة ٢٢١: من أراد أن يعظ ويخوّف ويقرع صَفاةَ القلب، ويعرّف الناس قدر الدنيا وتصرّفها بأهلها، فليأتِ بمثل هذه الموعظة فى مثل هذا الكلام الفصيح وإلاّ فليمسك، فإنّ السكوت أستر، والعىّ خير من منطق يفضح صاحبه، ومن تأمّل هذا الفصل علم صدق معاوية فى قوله فيه: "و الله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره" وينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبةً فى مجلس وتُلِىَ عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدىّ بن الرقاع:
"قلمٌ أصابَ من الدواة مِدادها"[٥٠]
فلمّا قيل لهم فى ذلك قالوا: إنّا نعرف مواضع السجود فى الشعر كما تعرفون مواضع السجود فى القرآن.
وإنى لأطيل التعجّب من رجل يخطب فى الحرب بكلام يدلّ علي أنّ طبعه مناسب لطباع الاُسود والنمور وأمثالهما من السباع الضارية، ثمّ يخطب فى ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدلّ علي أنّ طبعه مشاكل لطباع الرهبان لابسى المسوح، الذين لم يأكلوا لحماً ولم يريقوا دماءً، فتارةً يكون فى صورة بِسطام بن قيس الشيبانى وعُتَيبة بن الحارث اليربوعى وعامر بن الطفيل العامرى، وتارةً يكون فى صورة سقراط الحَبر اليونانى ويوحنّا المعمَدان الإسرائيلى والمسيح بن مريم الإلهى.
واُقسم بمن تُقسم الاُمم كلّها به، لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلي الآن أكثر من ألف مرّة، ما قرأتُها قطّ إلاّ وأحدثتْ عندى روعةً وخوفاً وعِظةً، وأثّرت فى قلبى وجيباً[٥١] وفى أعضائى رِعدةً، ولا تأمّلتُها إلاّ وذكرتُ الموتي من أهلى وأقاربى وأرباب ودّى، وخيّلت فى نفسى أنّى أنا ذلك الشخص الذى وصف حاله.
وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا المعني، وكم وقفت علي ما قالوه وتكرّر وقوفى عليه، فلم أجد لشىء منه مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى، فإمّا أن يكون ذلك لعقيدتى فى قائله، أو كانت نيّة القائل صالحة ويقينه كان ثابتاً وإخلاصه كان محضاً خالصاً، فكان تأثير قوله فى النفوس أعظم، وسريان موعظته فى القلوب أبلغ[٥٢].
البيان والتبيين ـ فى بيان قول علىّ "قيمة كلّ امرئ ما يحسن" ـ: فلو لم نقف من هذا الكتاب إلاّ علي هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية، ومجزئة مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية، وغير مقصّرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه فى ظاهر لفظه، وكان الله عزّ وجلّ قد ألبسه من الجلالة، وغشّاه من نور الحكمة علي حسب نيّة صاحبه وتقوي قائله[٥٣].
رسائل الجاحظ: أجمعوا علي أنّهم لم يجدوا كلمةً أقلّ حرفاً، ولا أكثر ريعاً[٥٤]، ولا أعمّ نفعاً، ولا أحثّ علي بيان، ولا أدعي إلي تبيّن، ولا أهجي لمن ترك التفهّم وقصّر فى الإفهام، من قول أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضوان الله عليه: قيمة كلّ امرئ ما يحسن[٥٥].
المناقب لابن شهر آشوب عن الجاحظ فى كتاب الغرّة: كتب [علىّ ]إلي معاوية: غرّك عزّك، فصار قصار ذلك ذلّك، فاخشَ فاحش فعلك فعلّك تهدي بهذا، وقال : من آمن أمن ![٥٦] [٥٧]
المناقب لابن شهر آشوب ـ فى وصف علىّ ـ: وهو أخطبهم، ألا تري إلي خُطَبه مثل: التوحيد، والشقشقيّة، والهداية، والملاحم، واللؤلؤة، والغرّاء، والقاصعة، والافتخار، والأشباح، والدرّة اليتيمة، والأقاليم، والوسيلة، والطالوتيّة، والقصبيّة، والنخيلة، والسلمانيّة، والناطقة، والدامغة، والفاضحة، بل إلي نهج البلاغة عن الشريف الرضى، وكتاب خطب أمير المؤمنين عن إسماعيل بن مهران السكونى عن زيد بن وهب أيضاً ؟ ![٥٨]
مطالب السؤول ـ فى وصف علىّ ـ: علم البلاغة والفصاحة، وكان فيها إماماً لا يشقّ غباره، ومقدّماً لا تلحق آثاره، ومن وقف علي كلامه المرقوم الموسوم بنهج البلاغة صار الخبر عنده عن فصاحته عياناً، والظنّ بعلوّ مقامه فيه إيقاناً[٥٩].
تذكرة الخواصّ: كان علىّ ينطق بكلام قد حفّ بالعصمة، ويتكلّم بميزان الحكمة، كلام ألقي الله عليه المهابة، فكلّ من طرق سمعه راعه فهابه، وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة، والطلاوة والفصاحة، لم يسقط منه كلمة، ولا بارت له حجّة، أعجز الناطقين، وحاز قصب السبق فى السابقين، ألفاظ يشرق عليها نور النبوّة، ويحيّر الأفهام والألباب[٦٠].
أنساب الأشراف عن الشعبى: كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علىّ أشعر الثلاثة[٦١].
شرح نهج البلاغة عن ابن عرادة: كان علىّ بن أبى طالب يُعشّى الناس فى شهر رمضان باللحم ولا يتعشّي معهم، فإذا فرغوا خَطَبَهم ووعظهم، فأفاضوا ليلة فى الشعراء وهم علي عشائهم، فلمّا فرغوا خَطَبهم وقال فى خطبته:
اعلموا أنّ ملاك أمركم الدين، وعصمتكم التقوي، وزينتكم الأدب، وحصون أعراضكم الحِلم. ثمّ قال: قل يا أبا الأسود، فِيمَ كنتم تُفيضون فيه، أىّ الشعراء أشعر ؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين، الذى يقول:
ولقد أغتدى يدافعُ ركنى*** أعوجىٌّ ذو مَيعة إضريجُ
مِخْلَطٌ مِزْيَلٌ مِعَنٌّ مِفَنٌّ**** مِنْفَحٌ مِطْرَحٌ سَبُوحٌ خَروجُ[٦٢]
يعنى أبا دُواد الإيادى، فقال : ليس به، قالوا: فمن يا أمير المؤمنين ؟
فقال: لو رُفعت للقوم غايةٌ فجرَوا إليها معاً علمنا مَن السابق منهم، ولكن إن يكن فالذى لم يقُل عن رغبة ولا رهبة.
قيل: من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: هو المَلِك الضِّلّيل ذو القروح.
قيل: امرؤ القيس يا أمير المؤمنين ؟ قال: هو[٦٣].