
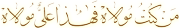
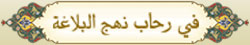


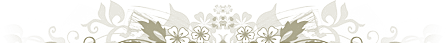

صبحي الصالح
لا بدّ لدارس «نهج البلاغة» أن يلمّ بهذه الوقائع التاريخية- ولومن خلال لمحة خاطفة عجلى- ليعرف السرّ في غروب شمس الخلافة الراشدة بين المسلمين الأولين الذين استروحوا شذا النبوّة، ونعموا بظلالها الوارفة، واستناروا بما يلوح من أضوائها الباقية وقد بدأت تنحسر بعيد الغروب!
ولا بدّ لدارس «النهج» أن يلمّ بهذه الحقائق ليرى رأي العين كيف تحوّلت هذه الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، وكيف أشعلت من أجلها الحروب الطاحنة، وأثخنت الأمة في سبيلها بالجراح الدامية، وأصيب مقتلها بمصرع إمام الهدى عليّ كرّم اللّه وجهه، ثمّ ارتكبت باسمها فيما بعد أسوأ الجرائم في عهود بعض السفهاء والخلعاء والجائرين الذين أمسوا نقمة على أتباع هذا الدين.
ثمّ لا بدّ لدارس «النهج» أن يكوّن لنفسه صورة حقيقية عن تلك الحقبة من تاريخ المسلمين، ليستنبط البواعث النفسية التي حملت عليا على الإكثار في خطبه من النقد والتعريض، والعتاب والتقريع، والتذمّر والشكوى، فقد عاندته الأيّام، وعجّت خلافته عجيجا بالأحداث المريرة، وخابت آماله في تحقيق الإصلاح. فهل من عجب إذا استغرقت معاني النقد اللاذع والتأنيب الجارح معظم خطبه ومناظراته، وحتّى رسائله إلى منافسيه والمتمردين عليه؟!
وإن خير مثال يصوّر لنا نفس عليّ الشاكية، خطبته «الشّقشقيّة» التي فاضت على لسانه هادرة، فكانت- كما قال- «شقشقة هدرت ثمّ قرّت»، وامتلأت بألفاظ التأوه والتوجّع والأنين.
ولكم تذمّر الإمام من تفرّق أصحابه عنه على حقهم واجتماع أصحاب معاوية معه على باطلهم! وكم سمّاهم «الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم» واصفا كلامهم بأنّه «يوهي الصمّ الصلاب» وفعلهم بأنّه «يطمع فيهم الأعداء».
وكان طبيعيا أن تكثر خطب الإمام في الحثّ على القتال، فإنّ ما تخلّل حياته السياسية من الأحداث المريرة ألهب مشاعره وأثار عواطفه، وحمله على الإهابة بقومه إلى القتال الدائب، والجهاد المتواصل. ولعلّ أفضل نمط لخطبه في الجهاد تلك التي أنّب فيها أصحابه على قعودهم عن نصرة الحق، يوم أغار جنود معاوية على الأنبار، فقتلوا ونهبوا، ثمّ آبوا سالمين ظافرين.
لقد كان- كما قال- لا يهدّد بالحرب، ولا يرهب بالضرب، وكان على يقين من ربّه وغير شبهة في دينه، فليفرطنّ لحزب الشيطان حوضا هوماتحه لا يصدرون عنه ولا يعودون إليه. وليوصينّ ابنه محمّد بن الحنفية يوم الجمل بما يجعله بطلا مرهوبا في ساحات القتال: «تزول الجبال ولا تزول، عضّ على ناجذك، أعر اللّه جمجمتك، تد في الأرض قدمك. ارم ببصرك أقصى القوم، وغضّ بصرك، واعلم أن النصر من عند اللّه سبحانه».
وبأمر الحرب تتصل السياسة، فإن بينهما لعلاقة وثقى، ومن الظلم لشخصيّة عليّ أن نتصوّره غير متتبّع تيارات السياسة في عصره، فقد كان ثاقب الفكر، راجح العقل، بصيرا بمرامي الأمور، وقد أثرت عنه مواقف وأقوال وتصرفات تقوم دليلا على سياسته الحكيمة، وقيادته الرشيدة، لكنّ مثله العليا تحكّمت في حياته، فحالت دون تقبّله للواقع ورضاه بأنصاف الحلول، بينما تجسّدت تلك الواقعية في خلفه معاوية، وكانت قبل متجسّدة على سموونبل في الخليفة العظيم عمر بن الخطّاب.
ومن يرجع إلى «نهج البلاغة» يجد فيه عشرات الخطب- مثلما تصلح «نماذج» للشكوى والتقريع والنقد- تعطي صورة واضحة عن نظراته الثاقبة وآرائه البعيدة في مبادئ السياسة، وأساليب حكم الرعية، وإدارة شئونها، والحرص على دفع الفتن عنها، حتى تعيش في بحبوحة العز والرخاء.
ولكي تتدبّر هذا الأمر، ما عليك إلّا أن تقرأ خطبة لدى بيعته وإعلانه منهاجه في الحكم، أوتستعيد مواقفه من السيّدة عائشة أم المؤمنين، ووساطاته بين عثمان والثائرين عليه، وصبره الجميل في معالجة أمر معاوية وأهل الشام، وطول أناته في تفهم آراء شيعته، ومناظرته الخوارج قبل أن يخوض معهم ساحة القتال.
استمع إليه عليه السلام يضبط نفسه عن الانفعال، ويدحض الباطل بحجاج منطقي، وأسلوب يفحم المكابر، حين يقول للخوارج: «فلما أبيتم إلّا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن، وأن يميتا ما أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكما يحكم بما في القرآن، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء»، أويقول لرجل وفد عليه من قبل أهل البصرة: «أ رأيت لوأن الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث، فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلإ والماء. فخالفوا إلى المعاطش والمجادب ما كنت صانعا؟
قال: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلإ والماء. فقال له الإمام: «فامدد إذا يدك»، وإذا، الرجل يقول: «فواللّه ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجّة عليّ، فبايعته».
وإن «نهج البلاغة» ليضمّ- إلى جانب الموضوعات السابقة- طائفة من خطب الوصف تبوّئ عليّا ذروة لا تسامى بين عباقرة الوصّافين في القديم والحديث. ذلك بأنّ عليّا- كما تنطق نصوص «النهج»- قد استخدم الوصف في مواطن كثيرة، ولم تكد خطبة من خطبه تخلومن وصف دقيق، وتحليل نفّاذ إلى بواطن الأمور: صوّر الحياة فأبدع، وشخّص الموت فأجزع، ورسم لمشاهد الآخرة لوحات كاملات فأراع وأرهب، ووازن بين طبائع الرجال وأخلاق النساء، وقدّم للمنافقين «نماذج» شاخصة، وللأبرار أنماطا حيّة، ولم يفلت من ريشته المصوّرة شيطان رجيم يوسوس في صدور الناس، ولا ملك رحيم يوحي الخير ويلهم الرشاد.
على أن المهم في أدب الإمام عليه السلام تصويره الحسيّات، وتدقيقه في تناول الجزئيات، وقد اشتمل كلامه على أوصاف عجيبة لبعض المخلوقات حملت روعتها ودقة تصويرها بعض النقّاد على الارتياب في عزوها إلى أمير المؤمنين، كما في تصويره البارع للنملة والجرادة ولا سيما للطاوس. ولا بدّ من تحقيق هذا الأمر في غير هذه المقدّمة العجليّ، وهوما نسأل اللّه التوفيق لبيانه في كتاب مستقل اكتملت بين أيدينا معالمه، وسنصدره قريبا بعون اللّه.
أما النملة فقد وصف منها صغرها وحقارة أمرها، مشيدا بدقتها وحسن تصرفها، مسترسلا مع وصفه بأنفاسه الطوال، وأنغامه العذاب، وأخيلته الخصاب: إن النملة في صغر جسّتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر، وإنها تدبّ على الأرض دبيبا، وتنصبّ على الرزق انصبابا، وتنقل الحبّ إلى جحرها، جامعة في حرّها لبردها، وفي وردها لصدرها؛ ولا يفوت عليّا أن يصف لنا من النملة شراسيفها وغضاريفها وأطراف أضلاعها المشرفة على بطنها، وما في رأسها من عينها وأذنها، ثم يسوقنا إلى التفكير بعظمة الخالق الذي خلقها، ولم يعنه على خلقها قادر، وفطرها ولم يشركه في فطرتها فاطر!
وأمّا الجرادة فيصوّر الإمام دقيق أجزائها، ورهيف حواسّها، وجامح نزواتها، ويتمهّل وهويصف حمرة عينيها، وضياء حدقتيها، وخفاء سمعها، واستواء فمها، وقوّة حسّها.
ويتوقف قليلا عند نابيها اللذين بهما تقرض، ومنجليها اللذين بهما تقبض؛ ويعجب لسلطتها الرهيبة على الزرّاع في زرعهم، فلوأجلبوا بجمعهم لما استطاعوا لها ذبّا ولا دفعا مع أن حجمها لا يزيد على إصبع مستدقّة!
ويختم الإمام كلامه هذا بالتذكير بعظمة الخالق الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويعنوله خدّا ووجها، ويلقي إليه بالطاعة سلما وضعفا.
وكل هذا ليس بشيء إذا ما قيس بوصف الإمام للطاوس، فما ترك شيئا من شياته إلا وصفه وصفا دقيقا جميلا: فهويمشي مختالا كأنّه يزهوبما منحته الطبيعة من جمال، وقوائمه حمش كقوائم الديكة الخلاسيّة، وألوانه الزاهية المتنوعة تشبه ألوان الربيع أوموشيّ الحلل «فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت: جنى جني من زهرة كل ربيع، وإن ضاهيته بالملابس فهوكموشيّ الحلل أومونق عصب اليمن، وإن شاكلته بالحليّ فهو كفصوص ذات ألوان قد نطّقت باللّجين المكلّل»!
وإن الإمام ليعجب لشيء في هذا الحيوان لا بدّ أن يثير العجب حقا: فكلما سقطت منه ريشة نبتت مكانها ريشة جديدة تحمل الألوان نفسها والتقاسيم ذاتها.
ويتطرّق الإمام إلى علاقة الطاوس مع أنثاه، ويوضح كيف يدرج إليها مختالا، وينفي زعم من قال: إن الطاوس يلقح أنثاه بدمعة تسفحها مدامعه، ويثبت أن الملاقحة عند هذا الطائر لا تختلف عن الملاقحة لدى الفحول المغتلمة للضراب.
وينتهي وصف الطاوس أيضا بالتذكير بعظمة الخالق وحكمته في خلقه، كأن الوصف- مهما يبد مستقلا قائما بنفسه- إنّما يخضع للغرض الديني، وللعبرة التي لا بدّ أن ينبّه عليّ إليها الأسماع والقلوب.
ومن المتوقع- بعد هذا كله، بل قبل هذا كله- أن يدور معظم خطب الإمام حول التعليم والإرشاد، إذ كان ربيب الرسول، فنهل العلم من بيت النبوّة العظيم.
وكان لزاما عليه فوق هذا- بحكم مكانة الخلافة، وما يفترض في الخليفة من توجيه ووعظ وإرشاد- أن يخطب الناس كلّ جمعة، ويعرّفهم رأي الإسلام الصحيح في الفتن والملمّات والأحداث. ومن هنا كثرت خطبه في التحذير من الفتن، والدعوة إلى الزهد في الحياة الدنيا، والتذكير بالموت هادم اللذات ومفرّق الجماعات، ووصف أهوال القيامة والبعث والنشور، والترغيب في الجنة والترهيب من النار.
إن الإمام ليحذّر من الفتن التي تدوس بأخفافها، وتطأ بأظلافها، وتقوم على سنابكها، وإنّه ليدعوالناس إلى شقّ أمواج هذه الفتن بسفن النجاة، والتعريج عن طريق المنافرة، ووضع تيجان المفاخرة.
أما الدنيا فغرّارة ضرارة، حائلة زائلة، نافدة بائدة، أكالة غوّالة، لا ينال امرؤ من غضارتها رغبا إلّا أرهقته من نوائبها تعبا، ولا يمسي منها في جناح أمن إلّا أصبح على قوادم خوف. إنها غرور حائل، وضوء آفل، وظل زائل، وسناء مائل. فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ وما يصنع بالمال من عمّا قليل يسلبه، ويبقى عليه تبعته وحسابه؟
فلينظر الناس إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها، الصادفين عنها، ولا يغرّنهم كثرة ما يعجبهم فيها لقلة ما يصحبهم منها. وليذكروا دائما أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه، ولا تؤسى جراحه، يرمي الحيّ بالموت، والصحيح بالسقم، والناجي بالعطب.
وليمنع الناس من اللعب ذكر الموت، فهذا عائد يعود، وآخر بنفسه يجود، ولتصيرنّ الأجساد شحبة بعد بضّتها، والعظام نخرة بعد قوّتها، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها.
ولقد كان للناس في رسول اللّه أسوة حسنة: عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اللّه سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقّر شيئا فحقّره. وللناس في عليّ أسوة حسنة أيضا:
رقّع مدرعته حتّى استحيا من راقعها. ولما سأله سائل: ألا تنبذها عنك؟ أجابه: «اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السّرى»!
وإنّ عليّا كرّم اللّه وجهه لا يرى كالنار نام هاربها، ولا كالجنة نام طالبها، «حتى إذا انصرف المشيّع، ورجع المتفجّع، أقعد في حفرته نجيّا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. وأعظم ما هنالك نزول الحميم، وتصلية الجحيم، وفورات السعير، وسورات الزفير»!
ومن أطرف ما جادت به قريحة الإمام خطبه في بدء الخلق، وأوضحها في هذا الباب خطبته الطويلة التي استهلّ بها الشريف الرضي «نهج البلاغة»، وفيها يصف خلق السماوات والأرض وخلق آدم؛ وخطبته «ذات الأشباح» التي عرض فيها لتصريف الكون وتدبير الخلق، وتناول فيها بالوصف أبراج السماء، وفجاج الأرض، وما حولها من البحار وما تحتها من الماء؛ ثم خطبته «القاصعة» التي تضمنت تكوين الخليقة، وسجود الملائكة لآدم، واستكبار إبليس عن السجود له، وتحذير الناس «من مصيدة إبليس العظمى، ومكيدته الكبرى».
وأغراض عليّ في كتبه ورسائله وعهوده ووصاياه تشبه أغراضه في خطبه شبها شديدا:
كثرت فيها رسائل التعليم والإرشاد، وكتب النقد والتعريض، والعتاب والتقريع، وانضمت إليها بعض الوثائق السياسية والإدارية والقضائية والحربية. ورسائله جميعا مطبوعة بالطابع الخطابي، حتى ليكاد الباحث يعدّها خطبا تلقى لا كتبا تدبّج، إذ تؤلّف فيها الألفاظ المنتقاة، وتنسّق فيها الجمل المحكمات، فينبعث من أجزائها كلها نغم حلوالإيقاع يسموبنثرها الرشيق فوق مجالات الشعر الرفيع.
وإذا تجاوزنا خطب عليّ ورسائله إلى المختار من حكمه ألفيناه يرسل من المعاني المعجزة، والأجوبة المسكتة، ما ينبئ عن غزارة علمه، وصحة تجربته، وعمق إدراكه لحقائق الأشياء.
وحكم عليّ هذه منها ما جمعه الشريف الرضيّ تحت عنوان مستقل، نجد فيه مثل قوله «الناس أعداء ما جهلوا»، «لم يذهب من مالك ما وعظك»، «قيمة كل امرئ ما يحسنه»، «احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع»، ومنها ما انبثّ وتناثر ضمن فقرات خطبه.
ووصايا عليّ الاجتماعية تتجسد هاهنا بوضوح من خلال كلماته النوابغ وحكمه الحسان.
فهو يجلو أبصار صحبه وبصائرهم، ويودّ لو يغبقهم كأس الحكمة بعد الصّبوح.
يحذرهم من العلم الذي لا ينفع «فربّ عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه»، «والجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل»، «والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل».
ويخوّفهم عاقبة الظلم والجور «فليس في الجور عوض من العدل».
ويكرّه إليهم الشرّ «فالغالب بالشر مغلوب».
ويبغّض إليهم النفاق، فإنما يخاف عليهم كل منافق الجنان، عالم اللسان، يقول ما يعرفون، ويفعل ما ينكرون.
ويستعظم أمر الخيانة، فإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة.
وينهى عن الإسراف والتبذير، فإنما المال مال اللّه! ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهويرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند اللّه.
ويستعيذ باللّه من الفقر، فإنه منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت!
والفكرة في خطب عليّ ورسائله وحكمه عميقة من غير تعقيد، بسيطة من غير إسفاف، مستوفاة من غير إطناب، يلوّنها ترادف الجمل، ويزيّنها تقابل الألفاظ، وينسّقها ضرب من التقسيم المنطقي يجعلها أنفذ في الحس، وألصق بالنفس.
وكان ينبغي لعليّ أن تقذف بديهته بتلك الحكم الخالدة، والآراء الثاقبة، بعد أن نهل المعرفة من بيت النبوّة، وتوافرت له ثقافة واسعة، وتجربة كاملة، وعبقرية نفّاذة إلى بواطن الأمور.
وتتّسم أفكار عليّ غالبا بالواقعية، إذ كان يستمد عناصرها من بيئته الاجتماعية والجغرافية، فأدبه- من هذه الناحية- مرآة للعصر الذي عاش فيه، صوّر منه ما قد كان أوما هوكائن.
ولقد يطيب له أحيانا أن يصوّر ما ينبغي أن يكون، فتغدوأفكاره مثالية عصيّة على التحقيق.
وما من ريب في أن الكتاب والسنة قد رفداه بينبوع ثرّ لا يغيض، فتأثّر بأسلوب القرآن التصويري لدى صياغة خطبه ورسائله، واقتطف من القرآن والحديث كثيرا من الألفاظ والتراكيب والمعاني، وقد حرصنا على إبرازها في فهارس «النهج» من طبعتنا هذه.
وأمّا عاطفة عليّ فثائرة جياشة تستمد دوافعها من نفسه الغنيّة بالانفعالات، وعقيدته الثابتة على الحق، فما تكلم إلّا وبه حاجة إلى الكلام، وما خطب إلّا ولديه باعث على الخطابة، وإنّما تتجلى رهافة حسه في استعماله الألفاظ الحادّة، وإكثاره من العبارات الإنشائية كالقسم والتمني والترجي والأمر والنهي والتعجب والاستفهام والإنكار والتوبيخ والتقريع، مصحوبة كلها بترادف بين الفقرات، وتجانس بين الأسجاع، وحرص واضح على النغم والإيقاع.
وخيال عليّ- فيما يخلعه على موصوفاته من صور زاهيات- ينتزع أكثر ما ينتزع من صميم البيئة العربية إقليمية وفكرية واجتماعية. وتمتاز صور عليّ بالتشخيص والحركة، ولا سيّما حين يتسع خياله ويمتدّ مجسّما الأفكار، ملوّنا التعابير، باثّا الحياة في المفردات والتراكيب.
منقول من كتاب نهج البلاغة (صبحي الصالح) مقدمة الكتاب