
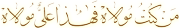
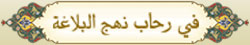


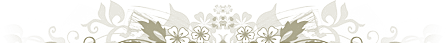

قبل أن نبدأ بالبحث عن هذا الموضوع نتحدث عن:
أوّلاً: مفهوم آفات الدين والتديّن
الآفة لغةً هي: العاهة، أو عرض مفسد لما أصابه[١].
الآفة اصطلاحاً هي: تلك الاُمور والمفاهيم التي من شأنها أن تؤدّي إلى فساد الدين والانحراف عنه.
وقد وردت هذه المفاهيم كراراً في كلام الإمام عليّ(عليه السلام):
• «صن إيمانك من الشكّ، فإنّ الشكّ يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل»[٢].
• «آفة الدين سوء الظنّ»[٣].
• «سبب فساد الدين الهوى»[٤].
• «غلبة الهوى تفسد الدين»[٥].
• «طاعة الشهوة تفسد الدين»[٦].
• «لا يسلّم الدين مع الطمع»[٧].
• «فساد الدين الطمع»[٨].
• «كثرة الكذب تفسد الدين وتعظم الوزر»[٩].
• «دع الحسد والكذب والحقد؛ فإنّهنّ ثلاثة تشين الدين وتهلك الرجل»[١٠].
ثانياً: أهمّية التعرّف على آفات الدين والتديّن
الدين هو: أجمل تجلّيات الرحمة الإلهيّة لهداية البشر.
والتديّن هو: الإقبال على هذه الرحمة والسير في طريق هديها.
وللدين معنيان:
الأوّل: بمعنى التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن تصل إليه الآفات.
الثاني: بمعنى تطبيق هذه الشريعة وفهمها، وهذا هو المقصود منه في هذا البحث، والذي تصل إليه الآفات؛ لأنّه من الشؤون البشرية.
لذا فإنّ الآفات والمضارّ في مبحث آفات الدين والتديّن إنّما ترجع إلى نمط توجّه الناس نحو الدين، أو فهم الإنسان واستيعابه للدين، أو نوع المعرفة الدينية، أو اُسلوب التديّن؛ وهذه كلّها شؤون كانت على الدوام موضع اختلاف وعرضه للآفات والمضارّ.
وقد وضّح ذلك الإمام عليّ(عليه السلام) حينما بعث عبد الله بن عبّاس لمحاورة الخوارج قائلاً له:
»لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإنّ القرآن حمّال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنّة، فإنّهم لن يجدوا عنها محيصاً»[١١].
كان للخوارج توجّهات سطحية للدين وفهم جامد للقرآن، الأمر الذي سار بهم في طريق الخطأ، ووضعهم على جادّة الضياع، إلاّ أنّهم كانوا يعتبرون تصوّراتهم القرآنية والدينية هذه عين الصواب.
يستوعب التديّن مجالين في الحياة:
الأوّل: النظري، وهو الأفكار والمعارف والمعتقدات الدينية والإيمان.
الثاني: العملي، وهو الإقرار والأفعال والسلوك الديني.
أي إنّه يشمل الأفكار والمعارف والمعتقدات الدينية والإيمان، كذلك الإقرار والأفعال والسلوك الديني. ورد في حِكم أمير البيان: «الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللّسان، وعمل بالأركان»[١٢].
وكلا المجالين النظري والعملي، عضة للإصابة بالآفات والمضارّ المختلفة.
وبعد أن استعرضنا هذه المقدّمة، نذكر آفات الدين والتديّن في نهج البلاغة، وأودّ أن أقول بأن الآفات والأضرار التي تهدّد الدين والتديّن في أقوال وكتب الإمام(عليه السلام)، بعضها داخلية أي من داخل الدين، وبعضها خارجية أي من خارج الدين، ولأجل ذلك سيتمّ التعرّف في هذا الدرس على قسمين:
أوّلاً: الآفات الداخلية للدين والتديّن
المراد من الآفات الداخلية: فهم الدين فهماً خاطئاً، كالإكراه والإجبار، وعدم التدرّج والتمكّن من الهداية والتربية، وجرّ التديّن إلى التكلّف. ومن جملة هذه الآفات:
١ ـ الإكراه في الدين
الدين حقيقة معنوية وجوهر روحاني يتعامل ويتعاطى مع روح الإنسان وفؤاده، وما لم يحصل التقبّل والإقبال القلبي عليه سينسلخ السلوك الديني عن هويّته الحقيقية، ويبتعد عن ماهيّته الفطرية.
المعتقد الديني والإيماني ليس شيئاً يحصل بالإكراه والإجبار، والتهديد والتطميع، والشدّة والعنف؛ لأنّهما من سنخ الحبّ والارتباط القلبي للإنسان بأجمل التجلّيات الرحمانية للحقّ تعالى؛ وإذا انقلبت أجمل التجلّيات الرحمانية هذه بواسطة الإكراه والإجبار والتهديد والتطميع والشدّة والعنف، فلن يبقى معنى للحبّ، ولا قبول من أعماق الوجود والتسليم الحقيقي والاتّباع الانتخابي الواعي.
ليس للإكراه والإجبار معنىً في الاُمور المتعلّقة بقلب الإنسان وروحه؛ والدين أمر يتعلّق بقلب الإنسان وروحه، والتديّن حصيلة نمط من العلاقة يقيمها الإنسان مع الحقيقة المتعالية للدين.
ومن هنا، كان الإكراه والإجبار في الدين ممّا يؤدّي إلى أضرار أساسية في الدين والتديّن. قال تعالى: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ »[١٣].
الإيمان معرفة واعتقاد قلبي، والتديّن نابع من مثل هذا الإيمان، ولا سبيل إلى الإكراه والإجبار فيما هو من سنخ المعرفة والاعتقاد القلبي. قال الإمام عليّ(عليه السلام) في حكمة متألّقة حول ماهيّة الإيمان وتجلّياته حينما
سألوه عنه:
«الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللّسان، وعمل بالأركان»[١٤].
إذا كان للإكراه والإجبار دور في الاُمور ذات العلاقة بقلب الإنسان وروحه، فسيؤدّي ذلك إلى نفور الفؤاد وعماه، وما يرشح عن القلب الأعمى فهو مصاب بشتّى الآفات والأمراض. وللإمام عليّ(عليه السلام) في هذا الشأن كلام واضح وصريح حينما قال:
«إنّ للقلوب شهوةً وإقبالاً وإدباراً، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإنّ القلب إذا اُكره عَمِي»[١٥].
٢ ـ سوء فهم الدين
إذا لم يُفهم الدين بصورة صحيحة عميقة، فسيحصل لدى الإنسان فهم عليل وتصوّرات ناقصة ومريضة، ومثل هذا الفهم لا يقود إلى مقاصد الدين، إنّما يدور حول نفسه. قال أمير المؤمنين(عليه السلام):
«المتعبّد على غير فقه، كحمار الطاحونة، يدور ولا يبرح»[١٦].
التديّن الفارغ من الفهم الصحيح للدين، مسرحية لأعمال دينية في ظاهرها، لكنّها خالية من روح الدين وحقيقته، وبالطبع فهي خالية من محتوى الدين ولا نصيب لها من النتائج المترتّبة عليه. وعلى حدّ تعبير الإمام عليّ(عليه السلام):
«كم من صائمٍ ليس له من صيامه إلاّ الجوع والظمأ، وكم من قائمٍ ليس له من قيامه إلاّ السهر والعناء، حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم»[١٧].
إذا كان الانشداد إلى الدين خالياً من الفهم الصحيح، فإنّه سيؤدّي إلى الإضرار بالدين والتديّن، ومثل هذا التديّن معناه تنسّك جاف وتعبّد بلا روح وفهم معوج.
حذّر الإمام عليّ(عليه السلام) من هكذا تعامل مع الدين قائلاً:
«ولا تكونوا كجفاة الجاهلية، لا في الدين يتفقّهون، ولا عن اللَّه يعقلون، كقيض بيض في أداحٍ يكون كسرها وزراً ويخرج حضانها شرّاً»[١٨].
إنّ سوء فهم الدين خطير وكارثي إلى درجة حذّر منه الإمام بهذه الصورة، وشبّه عديمي الفهم العميق للدين بأنّهم وحالهم كبيضة أفعى في عشّ طيور، كسرها ذنب؛ لأنّها قد تكون بيضة طائر، لكن ما يخرج منها شرّ وضرر؛ لأنّها في الحقيقة بيضة أفعى.
هكذا فهم الإمام عليّ(عليه السلام) المتديّنين في الظاهر، لكنّهم بسبب عدم فهمهم للدين يسيرون على جادة الجاهلية، أي أنّ معاقبتهم والتصدّي لهم غير جائز؛ لأنّهم يظهرون الإسلام، ولكنّهم لعدم فهمهم يتسبّبون في ألف شرًّ وفسادٍ، وقد عبّر(عليه السلام) عن هكذا تديّن وتنسّك بقوله: «ربّ متنسّك ولا دين له»[١٩].
٣ ـ التكلّف في الدين والتديّن
التكلّف لغةً: هو بمعنى التجشّم أو المشقّة[٢٠].
ذكر الراغب الإصفهاني:
«إنّ تكلّف كلمة تُطلق على العمل الذي يؤدّي بمشقّة أو تصنّع أو حرص. لذلك فهو على قسمين:
الأوّل: تكلّف محمود: وهو الحالة التي تحضّ الإنسان على بلوغ ما يريده ويصبو إليه، وتسهّل عليه العمل الذي يمارسه، وتجعله محبوباً إلى نفسه، ولذلك تُستخدم مفردة التكليف في باب التكلّف في العبادات.
الثاني: تكلّف مذموم: وهو الحالة التي يمارس فيها الإنسان فعله برياء وتصنّع، وفي هذا المعنى قال الله تعالى: «قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَاْ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»[٢١].
وقال الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم): «أنا وأتقياء اُمّتي براء من التكلّف»[٢٢].
التكلّف اصطلاحاً: هو فرض دساتير وقواعد في مساحة من الدين والتديّن، جعلها الشارع المقدّس منطقة فراغ وترك المكلّفين فيها أحراراً، قال تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها»[٢٣].
ولاشكّ أنّ إيجاد مثل هذا التكلّف خلاف الدين الفطري، ولأنّه أمر مفروض على منطقة فراغ دينية، لذلك سيؤدّي إلى المشقّة، ولا يمكن التديّن بمشقّة، مضافاً إلى أنّه يفضي إلى التظاهر والرياء.
فالدين مثلاً رسم حدوداً لغذاء وملبس المؤمنين، وتركهم أحراراً داخل هذه الحدود، فإذا أقدم البعض بدافع الجهل أو التحجّر أو التعنّت أو التظاهر بالقداسة على إيجاد قيود وأغلال داخل هذه الحدود التي ترك الشارع المقدّس المؤمنين أحراراً فيها، ضاربين بعرض الجدار حرّية الاختيار وتنوّع المراتب وتعدّد الأذواق في منطقة الفراغ، فسينجرف الدين والتديّن إلى التكلّف المذموم الضارّ.
إنّ إيجاد التكلّف في الدين والتديّن بمعنى تبديل منطقة فراغ التديّن إلى منطقة مملوءة بالأوامر والنواهي، سيجرّ الناس إلى التكلّف والتصنّع، ويضعف الدين والتديّن ويضرّهما؛ لأنّ فرض أوامر ونواه داخل الحدود الحرّة للدين خلاف روح الشريعة.
«قال رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ اللَّه تعالى حدّ لكم حدوداً فلا تتعدّوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وسنّ لكم سنناً فاتّبعوها، وحرّم عليكم حرمات فلا تهتكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمةً منه [لكم] من غير نسيانٍ فلا تتكلّفوها»[٢٤].
إنّ التظاهر بالقدسية والإفراط فيها يدفع المرء إلى تجاهل مثل هذه التعاليم السامية، ظنّاً منه أنّ الدين يجب ألاّ تكون فيه منطقة فراغ، ولا ينبغي أن تُترك بعض الاُمور للمؤمنين أنفسهم ليتصرّفوا كيفما شاؤوا طبقاً لأذواقهم وبما يتلاءم مع عصرهم وبيئتهم.
إنّ التحجّر والتعنّت يفرض على الإنسان أن يطالب الدين بدساتير وقوانين في كلّ الاُمور، فإذا واجه مساحة ليس لها مثل هذه الدساتير الدينية وضع هو من نفسه دساتير وتكاليف، حتّى يصلح الحرّية والاختيار الذي منحه الشارع للناس!
مقتضى الجهل والتحجّر هو أنّ الإنسان حينما يواجه مناطق الفراغ الدينية، يتصوّر أنّ اللَّه الرحمن نسي تحديد تكاليف لهذه المناطق، إذاً فمن واجبه رسم حدود وقيود لها!
لكنّ الإمام عليّ(عليه السلام) يردّ بكلّ قوّة على هؤلاء القدسويّين المتحجّرين الجهلة حينما يقول:
«إنّ اللَّه افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ لكم حدوداً فلا تتعدّوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها»[٢٥].
إنّ الذين ينكرون وجود مناطق حرّة في الدين تكون ضرورية جدّاً للتديّن الصحيح، كالذين يعدّون دين اللَّه ناقصاً ويتحرّون إكماله. وعلى حدّ تعبير الإمام عليّ(عليه السلام):
«أم أنزل اللَّه سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه»[٢٦].
لاريب أنّ الإسلام دين كامل لكلّ الأجيال ولكلّ العصور، ومن لوازم مثل هذا الدين ألاّ يكون فيه تكلّف، بل يترك أهل الإيمان أحراراً في بعض المساحات، فتكون الحرّية هناك هي التكليف حتّى لا ينزلق الدين والتديّن إلى التكلّف.
الواقع أنّ هذه القاعدة إذا لم تُراع وبادر البعض إلى التكلّف في الدين والتديّن، فستلحق الدين والتديّن أضرار خطيرة قد لا يمكن جبرها.
ثانياً: الآفات الخارجية للدين والتديّن
المقصود من الآفات الخارجية هي: تلك الأعمال والتصرّفات المرتبطة بالعوامل الاجتماعية والسياسية المؤثّرة على الواقع البشري، ومن تلك الآفات:
١ ـ سلوك العلماء وتأثيرهم على الدين والتديّن
إنّ سلوك الأفراد ـ الذين يُعرف عنهم أنّهم رجال الدين ورموزه ـ له تأثير حاسم على الدين والتديّن لدى الناس، فإنّ علماء الدين والمبلّغون والمربّون والمعلّمون، وكلّ من يراه الناس باعتباره من الشخصيات الدينية بشكلٍ من الأشكال، يتوقّعون منهم تديّناً تامّاً كاملاً.
بل إنّ الإنسان قبل أن يتأثّر بأقوال الشخصيات الدينية وكلامهم وتبليغهم، يتأثّر بسلوكهم وأفعالهم وممارساتهم، لذا فإنّ سلوك الشخصيات الدينية ـ ولاسيّما علماء الدين ـ على جانب كبير جدّاً من الأهمّية في تعزيز مكانة الدين أو تضعيفه أو نشره أو تنفير الناس منه.
العلماء الذين يشكّلون خطراً على الدين وعلى سلوكيات المجتمع الإسلامي على أصناف، منهم:
أ) العلماء الذين لا يعملون بعلمهم
هؤلاء يشكّلون خطراً على الدين وعلى سلوك المجتمع الإسلامي، وتوصية الإمام عليّ(عليه السلام) في هذا الشأن مهمّة جدّاً:
«مَن نصّب نفسه للناس إماماً، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلّم الناس ومؤدّبهم»[٢٧].
إنّ صلاح المجتمعات وفسادها منوط بقوّة سلوك الشخصيات الدينية. وفي المجتمعات التي تحكمها حكومة دينية يتحمّل علماء الدين والفقهاء وكذلك المسؤولون والحكّام مسؤوليات أكبر من الجميع في هذا الميدان. روي عن الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال:
«صنفان من اُمّتي إذا صلحا صلحت اُمّتي، وإذا فسدا فسدت اُمّتي. قيل: يا رسول الله، ومن هما؟ قال: الفقهاء والاُمراء»[٢٨].
إذا لم يعمل علماء الدين بعلمهم، تضاعف خطر اهتزاز العقائد الدينية والالتزام الديني لدى الناس، وحينما لا يعمل علماء الدين بعلمهم؛ فإنّهم في الواقع يعرّضون الناس لمشكلات فكرية تتعلّق بالدين والتديّن، ومن ذلك أنّهم سيجرّون الناس إلى أسئلة من قبيل: ما الإشكال في ألاّ يعمل علماء الدين بما يعلمون وما يدعون الآخرين إليه؟ ألا يجب على الدين بالدرجة الاُولى أن يؤدّبهم بآدابه ويجعلهم من أهل العمل والالتزام بتلك الآداب؟ أليسوا يعلمون اُموراً هي التي تدفعهم إلى مثل هذا السلوك والأعمال؟
لا يمكن للناس أن يفصلوا بسهولة بين الدين والتديّن من ناحية، وبين العلماء غير العاملين، وهذا ما يعرّض معتقدات الناس الدينية لأمواج التشكيك والغموض، وفي حال عدم توفّر ملاكات الدين والعُروة الوثقى، فإنّ تهرّب الناس من الدين والتديّن سيكون ظاهرة طبيعية.
قال الإمام الصادق(عليه السلام): في توصية سامية:
«إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياه فاتّهموه على دينكم؛ فإنّ كلّ محبّ لشيء يحوط ما أحبّ».
وقال(عليه السلام):
«أوحى الله إلى داوود(عليه السلام): لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتي، فإنّ أولئك قطّاع طريق عبادي المريدين»[٢٩].
ب) العلماء المنتهكون للقيم الدينية
إنّ سلوك وممارسات الشخصيات الدينية لا تُفهم بطابعها الشخصي والفردي، وصلاحهم وفسادهم ينتقلان إلى المجتمع بحسب مراتبهم ودوائر نفوذهم وعملهم.
بالنظر للمكانة الخطيرة للشخصيات الدينية في المجتمع وتوقّعات الناس منهم، فإنّ علماء الدين إذا أساؤوا العمل وتصرّفوا بخلاف ما يدعون إليه، فستلحق الدين والتديّن أشدّ المضارّ والآفات.
إذا انتهكت القيم والسلوكيات الدينية من قبل الذين لا يتوقّع هذا منهم على الإطلاق، فإنّ العقيدة الدينية لدى الناس ستتزعزع، وتتقوّض ميولهم نحو الدين والتديّن.
قال الإمام عليّ(عليه السلام) في حكمة نيّرة لجابر بن عبد الله الأنصاري(رضوان الله عليه)[٣٠]:
«يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلّم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلّم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه»[٣١].
فعلى هذا، يجب أن تتوفّر للدين والتديّن معايير جلية مُحكمة، ولا تخلط أوراق قطّاع طرق الدين بأوراق الدين، إنّما ينبغي الفصل بكلّ صراحة بين طريق الإسلام النبويّ والعلويّ، وطريق إسلام السلطويّين والمفسدين؛ حتّى لا تتلوّث ساحة الدين ولا يتشوّه وجهه.
قال الإمام عليّ(عليه السلام):
«لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به»[٣٢].