
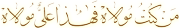
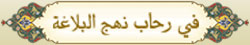


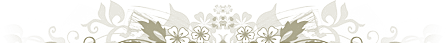

وكان السيد عبد الزهراء الخطيب من هؤلاء الافاضل الذين عناهم الشيخ كاشف الغطاء، فلم يسبقه من حيث التقدم الزمني الا الشيخ نعمة في «مصادر نهج البلاغة» والشيخ هادي كاشف الغطاء في «مدارك نهج البلاغة»، الا انّه رام مراماً اوسع وتكلف سفراً ابعد، وهاله ان يعجز استاذه عن هذه المهمة، واستوحشت نفسه الطريق فنراه يقول «فكيف بي ـ رعاك الله ـ وانا في الخضر (قضاء يتبع اليوم محافظة المثنى) وليس في متناول يدي الا بضع عشرات من الكتب لا يغني معظمها في مثل هذا المقام، ولا اجد من حولي من يمكن الاستعانة به في مثل هذا الامر».
ويمكن لك ان تحس روحاً ظريفة خلف هذا التعبير وابتسامة صافية وراء هذه الحسرة المذابة، وهي روح لم يتخل عنها في ثنايا الكتاب، فعند تحقيقه قول علي (ع) في عمرو بن العاص: «عجباً لابن النابغة، يزعم لاهل الشام ان فيّ دعابة واني امرؤ تلعابة اعافس وامارس، لقد قال باطلاً ونطق آثماً.. إلى آخر الخطبة.
وأصل الكنية التي اشار اليها الامام (ع) ننقلها من كتاب «مصادر»: ان «النابغة المذكورة في كلام علي (ع) هي سلمى أو ليلى الحبشية، كانت امة لرجل من عنزة ـ بالتحريك ـ سبيت فاشتراها الفاكه بن المغيرة، ثم اشتراها عبد الله بن جدعان التيمي، وكانت بغياً من ذوات الرايات، اشهر بغي بمكة وارخصهن اجرة، وقع عليها في طهر واحد خمسة أو ستة نفر من قريش، منهم العاص بن وائل السهمي، وابو لهب، وابو سفيان، وامية بن خلف الجمحي، وهشام بن المغيرة، فولدت عمراً، فاختصم القوم فيه جميعاً كل يزعم انّه ابنه ثم اضرب عنه ثلاثة، وأكب عليه اثنان العاص بن وائل وابو سفيان بن حرب، فقال ابو سفيان اما اني لا اشك اني وضعته في رحم امه، فأبت الا العاص».
ويعلق السيد الخطيب في الهامش ما نصه: «اقول: جزى الله عمّنا ابا لهب ما جزاه به إذ كان في جملة المضربين، والا وقعنا في محنة عظيمة، وورطة قد يصعب علينا النجاة منها»[١] (يقصد انّه كان سيوضع ضمن آل هاشم فيبتلي به السادة).
اما من حيث منهج السيد الخطيب في التحقيق، فان غاية ما يريده هي اثبات ان نصوص نهج البلاغة واردة عن طريق غير طريق الشريف الرضي، وهذا يكون بواسطة سبل اربعة، عددها المؤلف في مقدمة الكتاب، هي[٢]:
١ ـ مصادر ألفت قبل سنة(٤٠٠) وهي سنة صدور «نهج البلاغة» إلى عالم النشر ولا تزال موجودة إلى اليوم وقد نقل عنها مباشرة.
٢ ـ مصادر الفت قبل صدور النهج ولكنه نقل عنها بالواسطة.
٣ ـ كتب الّفت بعد النهج ولكنها روته باسناد متصل لا يمر بالشريف الرضي.
٤ ـ كتب صدرت بعد النهج، نقلت كلام الامام بصورة تختلف عما في النهج ولم تشر إليه اي ان مصدرها ليس كتاب «نهج البلاغة».
واسلوبه في التحقيق هو انّه يثبت الخطبة أو الرسالة أو الحكمة كما جاءت في النهج ثم يذكر الكتب التي اوردتها والصورة التي وردت بها، إذا كان هناك اختلاف في النقل، مع شرح للنص أو بعض ما جاء فيه إذا لزم الامر، وتوثيق المعلومات التاريخية المتعلقة بالرجال والحوادث والاشعار وتفسير الكلمات الغريبة، من دون الدخول في مباحث مطولة، ولكنه ربما جاء على مناسبة النص أو ألحقه بما حذف منه وذكرته مفصلاً مصادر اخرى، مثلما فعل في الحكمة رقم(٢٨٧) ونصها: «وقال عليه السلام، وقد سئل عن القدر: طريق مظلم فلا تسلكوه، ثم سئل ثانياً، فقال: بحر عميق فلا تلجوه، ثم سئل ثالثاً، فقال: سر الله فلا تتكلفوه» فذكر ما جاء بعد ذلك في رواية مأخوذة من كتاب «فقه الرضا» المذكور في كتاب «البحار»[٣].
ان المجال الذي تقحمّه السيد الخطيب لم تقل فيه الكلمة الاخيرة وان الباب ما يزال مفتوحاً امام من اراد تكملة مشروعه الرائد.
ويكفيه انّه وضع الاساس على خير قاعدة واوضح منهج. واعتقادي اكيد بان لو فسح له في الاجل لأتى بامور اوسع واشمل واكمل وأدق، ولكن كثرة الترحال واختلاف الزمان منعا من ذلك. وان فرصة الباحثين في هذا المجال ستكبر مع الايام لان التوجه القائم الآن في الشرق الاسلامي وفي الغرب، يميل إلى التوسع في نشر كنوز التراث القديم المذخورة في مخطوطات تتوزعها مكتبات العالم. وهذا كفيل بان يلقي الضوء على المساحة الزمنية التي تقع قبل عام ٧٠ هجرية أو نحوه.
وكتب هذه الفترة اما انها متناثرة في كتب التاريخ والادب، أو انها مفقودة. والقليل جداً منها وصل إلى حال النشر مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي عن حرب الجمل، وقد توفي المؤلف في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. وهناك كتب اخرى لم تصلنا مثل كتاب «تفسير القرآن» لحمزة بن دينار الثمالي، وهو من اصحاب الامام علي (ع)، وقيل ان لابي بن كعب (ت٢١ هـ) كتاب فى فضائل القرآن[٤].
وقد اهتم المستشرق جوزيف فان ايس بنشر جملة من الرسائل المتعلقة بعلم الكلام، في محاولة للوقوف على بداياته، فنشر رسالة «الارجاء» المنسوبة إلى الحسن بن محمد بن الحنفية، وكذلك «رسالة في الرد على القدرية» للحسن نفسه وهي مكتوبة عام ٧٣هـ، وبذلك تكون سابقة على رسالة مشابهة كتبها الحسن البصري جواباً على سؤال للحجاج، ورسالة اخرى في موضوع القدر ايضاً كتبها عمر بن عبد العزيز بعد نحو ربع قرن[٥].
وإذا فتحنا التحقيق في هذا الباب، فاننا نقع على نصوص كثيرة تشير إلى ان محمد بن الحنفية لديه علم خاص ورثه عن ابيه، وهو ليس علماً لدينا كما يذهب الشيعة الامامية في اختصاص الائمة المعصومين بمثل هذا العلم، وانما هو علم كسبي، فقد روي عنه قوله: «الحسن والحسين اشرف مني، وانا اعلم بحديث ابي منهما»[٦].
ونعرف من خلال روايات اخرى انّه ورث صحيفة مكتوبة من ابيه عليه السلام[٧].
واهمية هذا الموضوع هي ان محمد بن الحنفية يشكل حلقة وصل مع كثير من المذاهب الكلامية الإسلامية ويلقي الضوء على صلتها بعلي (ع) من جهة، ويمد من جهة اخرى دراسة علم الكلام الشيعي إلى فترة متقدمة جدا من صدر الاسلام، كما انّه يكشف عن طبيعة المباحث التي استفادها ابن الحنفية من ابيه (ع) ويقطع بامكان صدور ما نجده في «نهج البلاغة» من الفاظ ومباحث كلامية، عن الامام علي (ع).
وقد استفاد هذا المعنى ابن ابي الحديد في شرحه القيم، فقال في مقدمة كتابه[٨]:
«وما اقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها وابو عذرها وسابق مضمارها ومجلي حلبتها كل من بزغ فيها بعده فمنه اخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى» ثم يخصص المؤلف ذلك بمباحث التوحيد فيقول: «وقد عرفت ان اشرف العلوم هو العلم الالهي لان شرف العلم بشرف المعلوم ومعلومه اشرف الموجودات، فكان هو اشرف العلوم» ثم يقول بأنه «ومن كلامه عليه السلام اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه ابتدأ فان المعتزلة الذين هم اهل التوحيد والعدل وارباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن تلامذته واصحابه.
لان كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وابو هاشم تلميذ ابيه وابوه تلميذه عليه السلام، واما الاشعرية فانهم ينتمون إلى ابي الحسن علي بن ابي الحسن علي بن ابي بشر الاشعري وهو تلميذ ابي علي الجبائي وابو علي احد مشايخ المعتزلة، فالاشعرية ينتهون بآخره إلى استاذ المعتزلة ومعلمهم وهو علي بن ابي طالب عليه السلام، واما الامامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر».
ويورد الشيخ محمـد جـواد مغنيـة في كتابه «فلسفات اسلامية»[٩] خبراً نقله عن تفسير ملا صدرا في باب الجبر والقدر، ترد فيه اجوبة ائمة الحديث والكلام في البصرة والكوفة وكلهم يسند مقولته إلى علي (ع). والخبر بتمامه كما يلي:
«وكتب الحجاج بن يوسف إلى الحسن البصري وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وعامر الشعبي ان يذكروا له ما عندهم من العلم بالقضاء والقدر، فكتب إليه الحسن البصري: ان من احسن ما انتهى إلينا ما سمعته من امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال: اتظن ان الذي نهاك دهاك، انما دهاك اسفلك واعلاك، والله بريء من ذاك، والمراد باسفله واعلاه اقواله وافعاله.
وكتب إليه عمرو بن عبيد: احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب: لو كان الوزر في الاصل محتوما كان الموزر فى القصاص مظلوما، وكتب إليه واصل بن عطاء: احسن ما سمعت في ذلك قول أمير المؤمنين: ايدلك على الطريق، ويأخذ عليك المضيق؟ وكتب إليه الشعبي: احسن ما سمعت في قول أمير المؤمنين علي: كل ما استغفرت منه فهو منك، وكل ما حمدت عليه فهو منه تعالى».
وهذا يأتي بنا إلى المنهج البديل[١٠] الذي تقترحه في تحقيق «نهج البلاغة»، وهو ان يقوم التحقيق على اساس المضمون وقراءته في سياقه التاريخي وظروفه الاجتماعية واوضاع زمانه الفكرية. وسوف نعطي هنا مثالاً توضيحياً من معضلة توقف عندها بعض المتعرضين لشخصية الامام علي (ع) وعبقريته، مع اعجابهم المبالغ به، واستفاد منها اخرون للاشكال على «نهج البلاغة»، وهي قضية ورود مفردات اصطلاحية تخص علوم لم يعرفها المسلمون الا بعد سنوات طويلة على وقت صدورها.
وتخص هذه المفردات والصياغات التي جاءت ضمنها، اعقد قضايا علم الكلام، وهي الكلام في الذات والصفات الالهية. انظر مثلاً الخطبة التي يوردها ابراهيم بن هلال الثقفي المتوفي سنة ٢٨٣ هجرية في كتابه «الغارات»[١١]، وهو سابق على النهج بنحو مائة عام:
«فتبارك الله الذي لا يدركه بعد الهموم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس لصفته نعت موجود ولا وصف محدود ولا اجل ممدود وسبحان الذي ليس له اول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى، فسبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعمته، حد الاشياء كلها عند خلقه اياها ابانة له من شبهها وابانه لها من شبهه فلم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم يبن عنها فيقال هو عنها بائن ولم يخل منها فيقال له: اين؟ ولكنه احاط بها علمه، واتقنها صنعها وذللها امره، واحصاها حفظه، فلم يعزب عنه خفيات غيوب المدى..» إلى آخر الخطبة.
ويقول الكليني في باب جوامع التوحيد من اصول الكافي ان «هذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه السلام حتى لقد ابتذلها العامة وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها»[١٢].
وانظر اول خطبة من خطب «نهج البلاغة» في حديثه عن التوحيد ايضاً، وهي اشدها اثارة للمغرضين، يقول عليه السلام:
«اول التوحيد معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد اشار إليه ومن اشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال فيم فقد ضمنه، ومن قال علام فقد اخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، بصير اذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد اذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده انشأ الخلق انشاء وابتدأه ابتداءً، بلا روية اجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة احدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها..»[١٣].
وظاهر هذه الخطبة هو اوصاف بلاغية والفاظ جاءت على الاشتقاقات المألوفة في اللغة. قال السيد محسن الامين في ترجمته للامام علي (ع) في كتابه «اعيان الشيعة»: «وبعد كون اللفظة عربية والاشتقاق منها عربي لا يضر عدم اطلاع هؤلاء على وجودها في كلام العرب في جاهلية أو اسلام، ومتى احاطوا بكلام العرب أو بما نقل في كتب الادب من كلام العرب»[١٤].
ولكن هذا الدفاع لا ينجح في طرد الشبهة، مما يبقي الحيرة مرودة للعقول المنصفة، فهذا هو عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية الامام علي» يعترف بنسبة جميع فرق المسلمين إليه (ع) فيقول:
«وخاصة اخرى من خواص الامامة، ينفرد بها علي ولا يجاريه فيها امام غيره. وهي اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الإسلامية منذ وجدت في صدر الإسلام، فهو منشىء هذه الفرق أو قطبها الذي تدور عليه. وندرت فرقة في الإسلام لم يكن علي معلماً لها منذ نشأتها أو لم يكن موضوعاً لها ومحوراً لمباحثها، تقول فيه وترد على قائلين»[١٥] ولكنه حينما يصل خطب التوحيد يقول: «.. ففي كتاب نهج البلاغة فيض من آيات التوحيد والحكمة الالهية تتسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد واصول التأليه وحكمة التوحيد، وربما تشكك الباحث في نسبة بعضها إلى الامام لغلبة الصيغة الفلسفية عليها وامتزاجها بالآراء والمصطلحات التي اقتبست بعد ذلك من ترجمة الكتب الاغريقية والاعجمية، لا سيما الكلام على الاضداد والطبائع والعدم والحدود والصفات والمواصفات، ولكن الذي يقرؤه الباحث ولا يشك في نسبته إلى الامام أو في جواز نسبته إليه، قسط واف لتحقيق رأي القائلين بسبق الامام في مضمار علم الكلام»[١٦].
وهكذا نراه يعتذر بأدب جم عن رد الشبهة ولكنه لا يذهب مذهب اصحاب النفوس المغرضة. وهذا ما نقصده من الحاجة إلى فحص نصوص النهج من حيث سياقها الزمني وواقع عصرها الفكري والاجتماعي. ونجد عند ابن ابي الحديد امارات هذا المنهج وان لم يتعدها إلى ما سواها.
ويبدو ان ايمانه بقطعية صدور النهج عن أمير المؤمنين اوقفته عن الاستغراق في تحقيق المسألة واشهد له (إذا كانت لشهادتي قيمة) بالقابلية التامة على انجاز هذه المهمة، فهو في شرح الخطبة السابقة يتوقف عند كلمة «همامة» في قوله (ع): ولا همامة نفس اضطرب فيها» فقد فنّد الراي الذي يقول ان الهمامة بمعنى الهمة، فقال: «واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهمة، والذي عرفناه الهِمة والهَمة بالكسر والفتح والمهمة وتقول لا همام لي بهذا الامر مبني على الكسر كقطام ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند اهلها» وشرح ابن ابي الحديد هذا الاصطلاح، فقال: «حكى زرقان في «كتاب المقالات» وابو عيسى الوراق والحسن بن موسى وذكره شيخنا ابو القاسم البلخي في كتابه «المقالات» ايضاً عن الثنوية ان النور الاعظم اضطربت عزائمه وارادته فى غزو الظلمة والاغارة عليها، فخرجت من ذاته قطعة وهي الهمامة المضطربة في نفسه فخالطت الظلمة غازية لها، فاقتطعتها الظلمة من النور الاعظم وحالت بينها وبينه وخرجت همامة الظلمة غازية للنور الاعظم فاقتطعها النور الاعظم عن الظلمة ومزجها باجزائه وامتزجت همامة النور باجزاء الظلمة ايضاً ثم ما زالت الهمامتان تتقاربان وتتدانيان وهما ممتزجتان باجزاء هذا وهذا حتى انبنى منهما هذا العالم المحسوس» (وهذا يشبه الصيغة الدايالكتيكية) وإذا صح تفسير ابن ابي الحديد، يكون الامام (ع) على معرفة دقيقة بالمقالات الموجودة في زمانه وتلك السابقة عليه، وهذه المعرفة لا يمكن ان نكتفي بتفسيرها على انها معرفة لدنية[١٧]، اذ اننا نصل إلى حالة توقيفة لا نستطيع تجاوزها من جهة ولا يمكن لنا ان نلزم الناصبين بها، ولذا يتوجب اعادة بناء علم الكلام عند الامام علي (ع) في سياق تاريخي حضاري غير ما تعارفنا عليه من طرق الامور باجمالها، وتنبغي هنا مراعاة الدقة والتخصص والبحث التاريخي والفلسفي العميق واتخاذ نظرة شمولية تراقب بدقة صعود الحضارات وهبوطها وتغير خارطة نفوذها الجغرافي وانتقال مراكز الفكر فيها وظهور الفرق والاديان واصطراعها مع بعضها البعض الاخر.
وننتهز الفرصة هنا للرد على الشبهة المتقدمة في ضوء منهج التحقيق المقترح، فالرأي السائد هو ان بدايات علم الكلام نشأت في حدود النصف الثاني من القرن الهجري الاول[١٨].
وجلهم يربط بداياته باشخاص مثل: الجهم بن صفوان (مذهب الجبرية) ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي (مذهب القدرية) والحسن بن محمد بن الحنفية (مذهب الارجاء)[١٩].
ولا ينصف احد من الباحثين المدارك العقلية للنصف الاول من ذلك القرن، سوى مصطفى عبد الرزاق في كتابه «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» والذي فصّل القول في ان النظر العقلي عند المسلمين نشأ من البحث الفقهي والتوسع في استعمال الرأي والقياس[٢٠].
وتهمل هذه البحوث والتحقيقات، وبشكل غير مفسر دور الامام علي (ع) فى نشأة علم الكلام أو حتى موقعه منه، رغم ما يميل إليه المؤرخون من تصريحات عامة بمكانته فيه وفي غيره. ولعل ذلك يأتي من ان المجموع من كلامه لم يكن متوفراً في عصره أو في عهد قريب منه.
كما انّه يأتي ايضاً من الشك بمباحثه وعدم اخذها مأخذ الجد، لان البحث الكلامي في نظرهم لم يكن متوفراً، أو حتى ممكناً، في فترة الراشدين. ولكننا نذهب هنا إلى عكس هذا الرأي. وخلاصة ما نريد ان نقوله هو ان كلام امير المؤمنين علي (ع) في زمانه ممكن بمقاييس الفترة التي عاشها والبلاد التي تنقل فيها، بغض النظر عما نعتقده في شخصه (ع).